ثقافة وفن
مَن الذي يحدد معايير الإبداع الشِّعري: الأقلية «الهائلة» أم الحشد الكسول؟
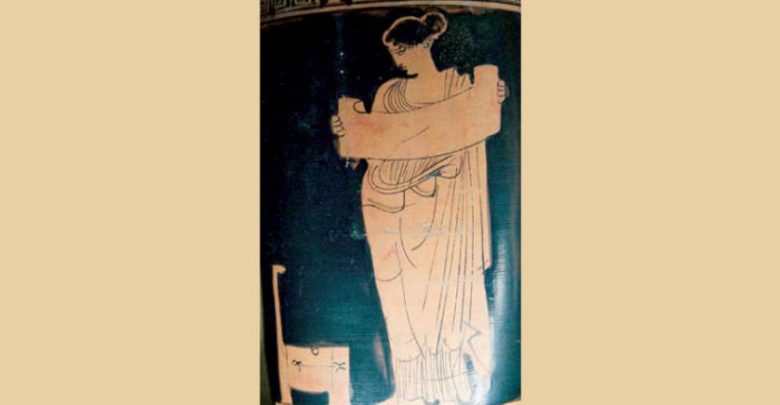
شوقي بزيع للشرق الاوسط
لا تزال العلاقة بين الشِّعر والجمهور محلاً للكثير من الجدل واللبس والسجال الذي يجدد نفسه بين حقبة وأخرى. ذلك أننا لا نزال نسمع حتى اللحظة، ورغم تحوّل الشِّعر عن دوره القديم، أصواتاً كثيرة تطلب من الشاعر أن يكون لسان حال الناس جميعاً لا لسان حال النخب المثقفة وحدها، وهو ما يوجب على الشِّعر أن يتصف بالمباشرة والوضوح التامّين. على أن الإشكالية المشار إليها ليست إشكالية معاصرة ترتبط بالفجوة القائمة بين لغة الكتابة ولغة المشافهة فحسب، بل هي تعود إلى قرون طويلة سابقة حيث كان الناس جميعاً يستخدمون الفصحى في الشوارع والبيوت والأماكن العامة. وربما اختُزلت الإشكالية تلك في الحوار الشهير الذي دار بين أبي تمام والرجل الأعرابي الذي استغلق عليه شعر حبيب بن أوس الطائي، فبادره بالسؤال الشهير: «يا أبا تمام، لماذا تقول ما لا يُفهم؟»، فأجابه هذا الأخير قائلاً بشيء من الامتعاض الساخر: «وأنت، لماذا لا تفهم ما أقول؟». والواضح أن ما لم يستطع طرفا الشِّعر الأساسيان، الشاعر والمتلقي، حله منذ قرون، لم يجد بعد ذلك طريقه إلى الحل. والأرجح أنه لن يجده في أي وقت، ولو أن مشكلة الإيصال تتفاوت في عمقها بين المجتمعات المتقدمة والأخرى المتخلفة. ففي كل حقبة من الزمن سنجد أناساً يطلبون من الشاعر «النزول» من برجه العاجي واتّباع طريق الوضوح والإفهام والتبسيط، لأنهم ليسوا مستعدين لمكابدة العناء والجهد بحثاً عن الفهم. وسنجد شعراء كثراً في المقابل يطلبون من الجمهور الصعود إليهم وملاقاتهم على ذرى اللغة والأخْيلة، لا في المنخفضات السهلة والهشة.
لقد واجهت الحداثة الشِّعرية منذ انطلاقتها قبل سبعة عقود ونيف الكثير من الحملات الشعواء التي اتهمت أصحابها ودعاتها بالتعمية والتعقيد والغرق في الغموض الشديد الذي يلامس حدود الأحاجي والمعميات. على أن الذين يأخذون على النموذج الشِّعري الحداثي نزوعه إلى الغموض والإبهام ينسون، أو يتناسون، أن أزمة الإيصال لا تتعلق بالقصيدة الحديثة وحدها، ولا بلغة الشِّعر بوجه عام، بل هي تتمثل بدايةً في طبيعة اللغة المكتوبة نفسها بما هي نظامٌ ترميزي منفصل عن الوجود المحسوس للأشياء والموجودات. وهو أمر يزداد تفاقمه في ظل ثنائية اللغة، حيث الهوة واسعة بين المكتوب والمنطوق. ولا بد لنا أن نسأل الذين يطلبون من الشاعر الحديث أن يكتب نصوصاً مفهومة للشرائح الاجتماعية: هل كان الشِّعر العربي التقليدي مفهوماً لهذه الشرائح؟ هل بمستطاع الجمهور الواسع الذي يردد أبياتاً سائرة لأبي تمام وأبي نواس والمتنبي، أن يفهم عشرات النصوص الشائكة لهؤلاء الشِّعراء؟ ثم لماذا من جهة ثانية يُطلب من الشِّعر ما لا يُطلب من النثر بأنواعه وأغراضه المختلفة؟ ذلك أنهم قليلون جداً أولئك الذين يتمكنون من فهم كتب تراثية نثرية من طراز «الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي، أو «المواقف» و«المخاطبات» للنفري، أو «الفتوحات المكية» لمحيي الدين بن عربي. وقليلون أيضاً أولئك الذين يتمكنون من فهم الكثير من كتب النقد والفلسفة وعلوم النفس والاقتصاد والاجتماع. لا بل إن الشاعر الألماني الشهير هانس أنسنسبرغر يعيد طرح هذه الإشكالية في مهرجان الأدب الدولي في برلين، فيقول بلغته الساخرة: «إن من التصورات الشائعة أن القصائد صعبة. لكن الحقيقة تؤكد أن الأشعار أيسر فهماً من برامج الأحزاب وشروط التعاقد بين الشركات، وإرشادات الاستخدام وعقود الإيجار».
ليس هناك من شاعر، من حيث المبدأ، إلا ويتمنى أن يكون مفهوماً من قراء كتبه على الأقل، وإلا لما سعى إلى طبع أعماله ونشرها على الملأ. لكن المشكلة الأصعب لا تتمثل في العلاقة بين الشاعر والمتلقين الأفراد الذين يقرأون نصوصه، كلٌّ على حدة، ويحوّلون تلك القراءة إلى نوع من كتابة جديدة لها، بل في العلاقة بين الشاعر والجمهور، حيث يخضع الكثير من شعراء المنابر لمتطلبات الحشد الكسول ويتماهى إلى حد بعيد مع استمرائه للنصوص السهلة والمسلية التي لا يتطلب فهمها أي جهد يُذكر. كما أن بعض من يستمرئون لعبة التصفيق ويلهثون خلفها، ينسون أو يتناسون أن التصفيق في غالبيته لا يبدو مكافأة على التخييل البعيد أو الصورة المدهشة، بل يأتي استمراءً لقفلة خطابية حماسية أو شعار سياسي مباشر. والحال أن هاجس الإيصال، كتابةً وإلقاءً، لا ينبغي أن يتحول إلى عقدة مستحكمة لدى الشاعر، أو أن يُفسد مبدأ الكتابة الأهم الذي يتمثل في الركون إلى العزلة والاختلاء التام بكشوف اللغة ومكابداتها. فالكتابة الحقيقية لا تتم إلا في تلك المناطق الملتبسة التي يتداخل فيها الضوء بالعتمة، والمرئي باللامرئي، والوعي باللاوعي. والشاعر بهذا المعنى لا يأتي إلى الكتابة مسلحاً بفرضيات مسبقة تتعلق بالوضوح والغموض، ولا يختار أشكاله بصورة متعمدة، بل هو يقتحم التجربة بلا دليل ظاهر، ولا يتراءى له منها سوى ما تُري الظهيرة للمسافر في الصحراء من سراب الأشكال. وهو ما تعبّر عنه الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس بقولها: «إن الكتابة هي المجهول في ذات الكاتب، في عقله وفي جسده. إنها شخص آخر يظهر ويتقدم على نحوٍ غير مرئي. لذلك فأن نكتب هو أن نسعى إلى معرفة ما سوف نكتبه».
وإذا كان قول دوراس ينسحب على لغة الأدب بوجه عام فهو ينسحب على الشِّعر أكثر من أي فن آخر. فالنص الجيد يفاجئ كاتبه ويثير دهشته قبل أي أحد آخر. لا بل إن ثمة جوانب من النصوص العالية تظل مستغلقة ومبهمة حتى بالنسبة إلى كتّابها أنفسهم، فكيف الحال مع القارئ أو المستمع؟! ذلك أن المسافة بين الشاعر في أثناء الكتابة وبين الشاعر خارجها هي المسافة نفسها بين المجاز والحقيقة، بين الباطن والظاهر، كما بين النص والقارئ. يصبح الشاعر بهذا المعنى واحداً من مئات القراء الذين يتعاقبون على النص، وتصبح قراءته لنصه واحدة من قراءات كثيرة ومتغايرة التفاسير. من هنا يمكن لنا أن نبحث عن القارئ بحثنا عن الشاعر. إذ لا يجوز أن نطلب من الثاني أن يوفر لنصوصه كل أسباب الفرادة والجدة، وأن يجازف بكل طاقاته وأعصابه في سبيل ذلك، في حين لا نطلب من الأول بذل أي جهد يُذكر لملاقاة الشاعر، لا بالضرورة في منتصف الطريق الشائك إلى الجمال، بل في نقطة منه على الأقل. لا يعني ذلك بالطبع أن نحوّل القراء جميعاً إلى شعراء أو نقاد، بل يعني أن من حق الشاعر أن يختار جمهوره، كما من حق الجمهور أن يختار شاعره. صحيح أن كل شاعر أو فنان يطمح إلى أن يكون نتاجه في متناول الجميع، ولكن الواقع على الأرض يؤكد أن كل فن من الفنون يحتاج فهمه وتذوقه إلى قدر وافر من الدراسة والتمرس المعرفي. وهذا ليس حال الفنون العليا كالموسيقى والرواية والرسم والمسرح وحدها، بل هو أيضاً حال المهن والحرف المختلفة التي تنحصر معرفتها في ذوي الخبرة وأهل الاختصاص. فنحن لا ننتظر من النجار أو الخباز أن يرشدانا إلى عيار الذهب، أو يساعدانا على التمييز بين الأصلي منه وبين الزائف، بل إن الصائغ الماهر هو من يرشدنا إلى ذلك، تماماً كما يرشدنا الناقد والمتذوق الحصيف إلى «عيار» الشِّعر. ونحن حين نريد الحصول على طاولة أو سرير، لا نذهب إلى الحلاق أو الخياط بل إلى النجار المحترف والماهر. في حين أن الشِّعر وحده يُترك في عُهدة الجميع، دون تمييز بين المتذوق الفطن وبين الجاهل البليد!
على أن من الخطأ في المقابل أن نتحدث عن أزمة التواصل بين الشِّعر والجمهور بشكل مطلق، ودون أن نميّز بين شاعر وآخر. فالبعض استطاع أن يضيّق الفجوة لا عن طريق التصميم المسبق والتقصد المفتعل، بل بحكم الموهبة المتقدة والصدق العاطفي والانصهار الكامل بلغته وموضوعه، أو بواسطة الإحالات المشهدية التي تؤالف بين الحسي والحدسي، أو عن طريق الإصغاء العميق إلى صوت الجماعة والحفر باتجاه المياه الجوفية التي يلتقي في رحابها عطش البشر وتوقهم المفرط إلى الارتواء الجمالي والروحي. ولا يضير الشِّعر بشيء أن يُمسرَح أو يُغنَّى أو يُلقَى على المنابر، ما دامت كتابته في الأصل قد أُنجزت بدوافع البحث عن الحقيقة الفنية والإنسانية، لا بدافع الصخب الاحتفالي أو توسُّل النجومية أو استدرار التصفيق. إذ علينا هنا أن نفرّق بوضوح تام بين منبرية الكتابة ومنبرية الإلقاء، حيث الأولى جائرة وسقيمة، والثانية مبررَّة ومشروعة. إن من الأجدى للشاعر أخيراً ألا يقع في شرَك الجمهرة الكمية المسطحة، التي لن تلبث أن تنفضّ عنه عندما تبدل ثوبها السياسي والآيديولوجي، أو يشتد عودها المعرفي والثقافي، بل أن يبحث عن قارئه في مناطق الظلال والعزلات والأسئلة الإنسانية المؤرقة. ولا بأس أن يوسَم الشاعر بالنخبوية والأقلوية، إذ إن تلك النخبة القليلة من المتلقين لن تكون سوى النواة الطليعية الأولى لمن ينعتهم الشاعر والناقد المكسيكي الشهير أوكتافيو باث بالأقلية الهائلة التي تُراكم نفسها ككرة الثلج على امتداد الزمن.
لقد واجهت الحداثة الشِّعرية منذ انطلاقتها قبل سبعة عقود ونيف الكثير من الحملات الشعواء التي اتهمت أصحابها ودعاتها بالتعمية والتعقيد والغرق في الغموض الشديد الذي يلامس حدود الأحاجي والمعميات. على أن الذين يأخذون على النموذج الشِّعري الحداثي نزوعه إلى الغموض والإبهام ينسون، أو يتناسون، أن أزمة الإيصال لا تتعلق بالقصيدة الحديثة وحدها، ولا بلغة الشِّعر بوجه عام، بل هي تتمثل بدايةً في طبيعة اللغة المكتوبة نفسها بما هي نظامٌ ترميزي منفصل عن الوجود المحسوس للأشياء والموجودات. وهو أمر يزداد تفاقمه في ظل ثنائية اللغة، حيث الهوة واسعة بين المكتوب والمنطوق. ولا بد لنا أن نسأل الذين يطلبون من الشاعر الحديث أن يكتب نصوصاً مفهومة للشرائح الاجتماعية: هل كان الشِّعر العربي التقليدي مفهوماً لهذه الشرائح؟ هل بمستطاع الجمهور الواسع الذي يردد أبياتاً سائرة لأبي تمام وأبي نواس والمتنبي، أن يفهم عشرات النصوص الشائكة لهؤلاء الشِّعراء؟ ثم لماذا من جهة ثانية يُطلب من الشِّعر ما لا يُطلب من النثر بأنواعه وأغراضه المختلفة؟ ذلك أنهم قليلون جداً أولئك الذين يتمكنون من فهم كتب تراثية نثرية من طراز «الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي، أو «المواقف» و«المخاطبات» للنفري، أو «الفتوحات المكية» لمحيي الدين بن عربي. وقليلون أيضاً أولئك الذين يتمكنون من فهم الكثير من كتب النقد والفلسفة وعلوم النفس والاقتصاد والاجتماع. لا بل إن الشاعر الألماني الشهير هانس أنسنسبرغر يعيد طرح هذه الإشكالية في مهرجان الأدب الدولي في برلين، فيقول بلغته الساخرة: «إن من التصورات الشائعة أن القصائد صعبة. لكن الحقيقة تؤكد أن الأشعار أيسر فهماً من برامج الأحزاب وشروط التعاقد بين الشركات، وإرشادات الاستخدام وعقود الإيجار».
ليس هناك من شاعر، من حيث المبدأ، إلا ويتمنى أن يكون مفهوماً من قراء كتبه على الأقل، وإلا لما سعى إلى طبع أعماله ونشرها على الملأ. لكن المشكلة الأصعب لا تتمثل في العلاقة بين الشاعر والمتلقين الأفراد الذين يقرأون نصوصه، كلٌّ على حدة، ويحوّلون تلك القراءة إلى نوع من كتابة جديدة لها، بل في العلاقة بين الشاعر والجمهور، حيث يخضع الكثير من شعراء المنابر لمتطلبات الحشد الكسول ويتماهى إلى حد بعيد مع استمرائه للنصوص السهلة والمسلية التي لا يتطلب فهمها أي جهد يُذكر. كما أن بعض من يستمرئون لعبة التصفيق ويلهثون خلفها، ينسون أو يتناسون أن التصفيق في غالبيته لا يبدو مكافأة على التخييل البعيد أو الصورة المدهشة، بل يأتي استمراءً لقفلة خطابية حماسية أو شعار سياسي مباشر. والحال أن هاجس الإيصال، كتابةً وإلقاءً، لا ينبغي أن يتحول إلى عقدة مستحكمة لدى الشاعر، أو أن يُفسد مبدأ الكتابة الأهم الذي يتمثل في الركون إلى العزلة والاختلاء التام بكشوف اللغة ومكابداتها. فالكتابة الحقيقية لا تتم إلا في تلك المناطق الملتبسة التي يتداخل فيها الضوء بالعتمة، والمرئي باللامرئي، والوعي باللاوعي. والشاعر بهذا المعنى لا يأتي إلى الكتابة مسلحاً بفرضيات مسبقة تتعلق بالوضوح والغموض، ولا يختار أشكاله بصورة متعمدة، بل هو يقتحم التجربة بلا دليل ظاهر، ولا يتراءى له منها سوى ما تُري الظهيرة للمسافر في الصحراء من سراب الأشكال. وهو ما تعبّر عنه الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس بقولها: «إن الكتابة هي المجهول في ذات الكاتب، في عقله وفي جسده. إنها شخص آخر يظهر ويتقدم على نحوٍ غير مرئي. لذلك فأن نكتب هو أن نسعى إلى معرفة ما سوف نكتبه».
وإذا كان قول دوراس ينسحب على لغة الأدب بوجه عام فهو ينسحب على الشِّعر أكثر من أي فن آخر. فالنص الجيد يفاجئ كاتبه ويثير دهشته قبل أي أحد آخر. لا بل إن ثمة جوانب من النصوص العالية تظل مستغلقة ومبهمة حتى بالنسبة إلى كتّابها أنفسهم، فكيف الحال مع القارئ أو المستمع؟! ذلك أن المسافة بين الشاعر في أثناء الكتابة وبين الشاعر خارجها هي المسافة نفسها بين المجاز والحقيقة، بين الباطن والظاهر، كما بين النص والقارئ. يصبح الشاعر بهذا المعنى واحداً من مئات القراء الذين يتعاقبون على النص، وتصبح قراءته لنصه واحدة من قراءات كثيرة ومتغايرة التفاسير. من هنا يمكن لنا أن نبحث عن القارئ بحثنا عن الشاعر. إذ لا يجوز أن نطلب من الثاني أن يوفر لنصوصه كل أسباب الفرادة والجدة، وأن يجازف بكل طاقاته وأعصابه في سبيل ذلك، في حين لا نطلب من الأول بذل أي جهد يُذكر لملاقاة الشاعر، لا بالضرورة في منتصف الطريق الشائك إلى الجمال، بل في نقطة منه على الأقل. لا يعني ذلك بالطبع أن نحوّل القراء جميعاً إلى شعراء أو نقاد، بل يعني أن من حق الشاعر أن يختار جمهوره، كما من حق الجمهور أن يختار شاعره. صحيح أن كل شاعر أو فنان يطمح إلى أن يكون نتاجه في متناول الجميع، ولكن الواقع على الأرض يؤكد أن كل فن من الفنون يحتاج فهمه وتذوقه إلى قدر وافر من الدراسة والتمرس المعرفي. وهذا ليس حال الفنون العليا كالموسيقى والرواية والرسم والمسرح وحدها، بل هو أيضاً حال المهن والحرف المختلفة التي تنحصر معرفتها في ذوي الخبرة وأهل الاختصاص. فنحن لا ننتظر من النجار أو الخباز أن يرشدانا إلى عيار الذهب، أو يساعدانا على التمييز بين الأصلي منه وبين الزائف، بل إن الصائغ الماهر هو من يرشدنا إلى ذلك، تماماً كما يرشدنا الناقد والمتذوق الحصيف إلى «عيار» الشِّعر. ونحن حين نريد الحصول على طاولة أو سرير، لا نذهب إلى الحلاق أو الخياط بل إلى النجار المحترف والماهر. في حين أن الشِّعر وحده يُترك في عُهدة الجميع، دون تمييز بين المتذوق الفطن وبين الجاهل البليد!
على أن من الخطأ في المقابل أن نتحدث عن أزمة التواصل بين الشِّعر والجمهور بشكل مطلق، ودون أن نميّز بين شاعر وآخر. فالبعض استطاع أن يضيّق الفجوة لا عن طريق التصميم المسبق والتقصد المفتعل، بل بحكم الموهبة المتقدة والصدق العاطفي والانصهار الكامل بلغته وموضوعه، أو بواسطة الإحالات المشهدية التي تؤالف بين الحسي والحدسي، أو عن طريق الإصغاء العميق إلى صوت الجماعة والحفر باتجاه المياه الجوفية التي يلتقي في رحابها عطش البشر وتوقهم المفرط إلى الارتواء الجمالي والروحي. ولا يضير الشِّعر بشيء أن يُمسرَح أو يُغنَّى أو يُلقَى على المنابر، ما دامت كتابته في الأصل قد أُنجزت بدوافع البحث عن الحقيقة الفنية والإنسانية، لا بدافع الصخب الاحتفالي أو توسُّل النجومية أو استدرار التصفيق. إذ علينا هنا أن نفرّق بوضوح تام بين منبرية الكتابة ومنبرية الإلقاء، حيث الأولى جائرة وسقيمة، والثانية مبررَّة ومشروعة. إن من الأجدى للشاعر أخيراً ألا يقع في شرَك الجمهرة الكمية المسطحة، التي لن تلبث أن تنفضّ عنه عندما تبدل ثوبها السياسي والآيديولوجي، أو يشتد عودها المعرفي والثقافي، بل أن يبحث عن قارئه في مناطق الظلال والعزلات والأسئلة الإنسانية المؤرقة. ولا بأس أن يوسَم الشاعر بالنخبوية والأقلوية، إذ إن تلك النخبة القليلة من المتلقين لن تكون سوى النواة الطليعية الأولى لمن ينعتهم الشاعر والناقد المكسيكي الشهير أوكتافيو باث بالأقلية الهائلة التي تُراكم نفسها ككرة الثلج على امتداد الزمن.






