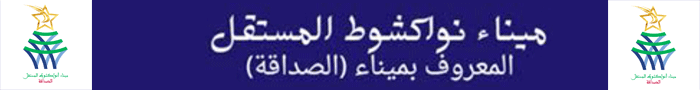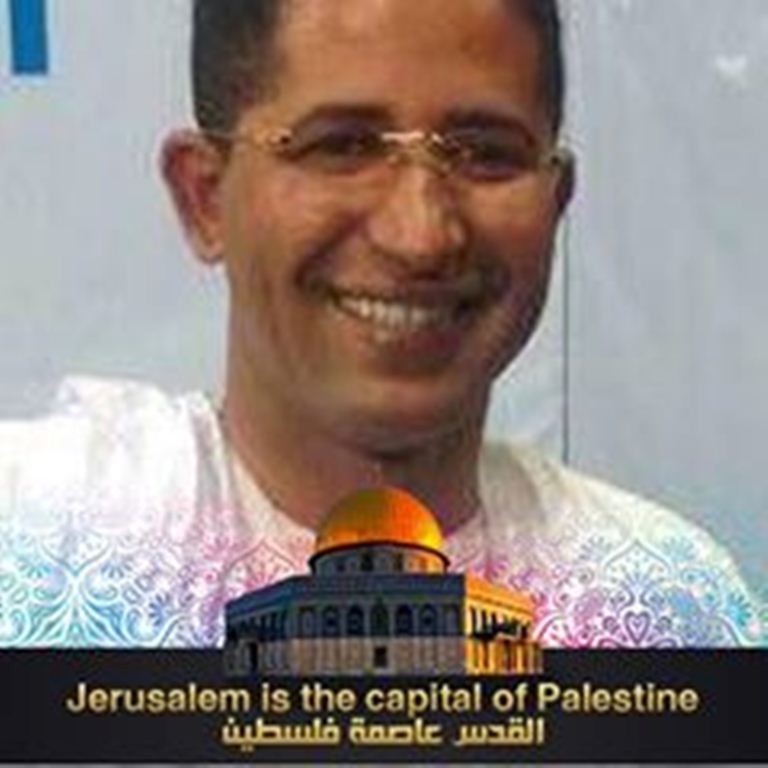آراءموضوعات رئيسية
نقد الإنتروبولوجيا والتمركز الأوروبي: حالة موريتانيا / قاسم صالح

شكلت الإنتروبولوجيا، منذ نشأتها في أوروبا القرن التاسع عشر، أحد أبرز العلوم التي تماهت مع المشروع الاستعماري. فبدلا من أن تكون أداة لفهم الثقافات وتقدير تنوعها، تحولت في سياقات متعددة إلى وسيلة لتكريس التمركز الأوروبي الذي يفترض تفوق الحضارة الغربية على بقية الشعوب.
وفي السياق الموريتاني، مثلت الكتابات الفرنسية حول المجتمع المحلي مثالا حيا على هذه العلاقة المعقدة بين المعرفة والسلطة، إذ لم يكن الهدف منها توصيف الواقع بقدر ما كان إعادة صياغته بما يخدم الهيمنة الاستعمارية.
إشكالية البحث
ينطلق هذا البحث من التساؤل: كيف ساهمت الإنتروبولوجيا الكولونيالية في إعادة إنتاج صورة مشوهة عن المجتمع الموريتاني، وكيف يمكن تفكيك هذا التمركز الأوروبي لصالح أنثروبولوجيا تحررية؟
الإطار النظري: الإنتروبولوجيا والتمركز الأوروبي
المعرفة والسلطة: تبعا لفوكو، لا يمكن فصل إنتاج المعرفة عن آليات السلطة. وقد كانت الإنتروبولوجيا، في كثير من السياقات الاستعمارية، أداة لتكريس الهيمنة عبر تصنيف المجتمعات.
التمركز الأوروبي: يقوم على رؤية تجعل من التجربة الغربية معيارا وحيدا للتاريخ والتقدم، وتقصي تجارب الشعوب الأخرى إلى الهامش أو ما قبل التاريخ.
الموقف الناصري: يرفض اختزال الإنسان العربي والإفريقي في صورة (موضوع) غربي، ويؤكد على أن تحرير الفكر والمعرفة شرط أساسي لتحرير الأرض والإرادة.
حالة موريتانيا
1. الكتابات الاستعمارية الفرنسية
بول مارتي (Paul Marty): في كتابه Études sur l’Islam en Mauritanie (1916)، صاغ رؤية للمجتمع الموريتاني بوصفه فضاء قبليا راكدا، وربط الإسلام فيه بالبدائية والتخلف، وهو تصوير يخدم سياسات التحديث الاستعماري.
بيير بونتي (Pierre Bonte): في L’émirat de l’Adrar mauritanien (1987)، ركّز على ثنائية (المخزن/السيبة)، مقدما صورة مجتمع بلا دولة مركزية، بما يعزز خطاب الحاجة إلى سلطة خارجية منظمة.
2. الإشكاليات البنيوية في هذه الكتابات
نزع التاريخ: تصوير موريتانيا كصحراء بلا حضارة، متجاهلين الإرث المرابطي ودور المنطقة في التاريخ الإسلامي.
التصنيف الإثني الجامد: تقسيم المجتمع إلى (عرب/زنوج) أو (أسياد/عبيد) في قوالب جامدة، دون إدراك لحركية التاريخ.
إقصاء الذات الموريتانية: غياب صوت الفاعلين المحليين، وتحويلهم إلى مجرد موضوعات مراقبة.
3. القراءات الوطنية والبدائل التحررية
عبد الودود ولد الشيخ: في كتاباته مثل Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie (1991)، أعاد النظر في البنية الاجتماعية بعيدا عن التنميط الكولونيالي.
الدكتورإشيب ولد اباتي: في مقالاته حول الهجرة والبنية الاجتماعية، قدم رؤية نقدية تنطلق من الداخل.
المصادر التراثية: مثل المخطوطات والشعر الشنقيطي، والتي تعكس صورة مغايرة لمجتمع متنوع لكنه فاعل تاريخيا وحضاريا.
نحو أنثروبولوجيا تحررية
استعادة السيادة المعرفية: من خلال كتابة تاريخنا بأنفسنا، والانفتاح على أدوات علمية معاصرة دون الوقوع في فخ المركزية الغربية.
أنسنة البحث: جعل الإنسان الموريتاني ذاتا منتجة للمعرفة، لا مجرد موضوع دراسة.
التأصيل القومي: إدراج التجربة الموريتانية في فضاء عربي-إسلامي جامع، يعزز الانتماء الحضاري ويقاوم محاولات التفتيت.
إن نقد الإنتروبولوجيا والتمركز الأوروبي في موريتانيا يفتح أفقا لمشروع تحرري يتجاوز الاستعمار المعرفي. فالمعرفة ليست حيادية، بل إما أن تكون أداة للهيمنة وإما أداة للتحرر. ومن هنا، فإن الحاجة ملحة إلى تأسيس مدرسة بحثية وطنية وقومية تستلهم روح النهضة الناصرية، حيث تصبح المعركة الفكرية جزءا لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني.
وكما قال جمال عبد الناصر: (المعركة الحقيقية هي معركة وعي، فمن يملك وعي الأمة يملك قدرتها على النهوض).
قاسم صالح.
وفي السياق الموريتاني، مثلت الكتابات الفرنسية حول المجتمع المحلي مثالا حيا على هذه العلاقة المعقدة بين المعرفة والسلطة، إذ لم يكن الهدف منها توصيف الواقع بقدر ما كان إعادة صياغته بما يخدم الهيمنة الاستعمارية.
إشكالية البحث
ينطلق هذا البحث من التساؤل: كيف ساهمت الإنتروبولوجيا الكولونيالية في إعادة إنتاج صورة مشوهة عن المجتمع الموريتاني، وكيف يمكن تفكيك هذا التمركز الأوروبي لصالح أنثروبولوجيا تحررية؟
الإطار النظري: الإنتروبولوجيا والتمركز الأوروبي
المعرفة والسلطة: تبعا لفوكو، لا يمكن فصل إنتاج المعرفة عن آليات السلطة. وقد كانت الإنتروبولوجيا، في كثير من السياقات الاستعمارية، أداة لتكريس الهيمنة عبر تصنيف المجتمعات.
التمركز الأوروبي: يقوم على رؤية تجعل من التجربة الغربية معيارا وحيدا للتاريخ والتقدم، وتقصي تجارب الشعوب الأخرى إلى الهامش أو ما قبل التاريخ.
الموقف الناصري: يرفض اختزال الإنسان العربي والإفريقي في صورة (موضوع) غربي، ويؤكد على أن تحرير الفكر والمعرفة شرط أساسي لتحرير الأرض والإرادة.
حالة موريتانيا
1. الكتابات الاستعمارية الفرنسية
بول مارتي (Paul Marty): في كتابه Études sur l’Islam en Mauritanie (1916)، صاغ رؤية للمجتمع الموريتاني بوصفه فضاء قبليا راكدا، وربط الإسلام فيه بالبدائية والتخلف، وهو تصوير يخدم سياسات التحديث الاستعماري.
بيير بونتي (Pierre Bonte): في L’émirat de l’Adrar mauritanien (1987)، ركّز على ثنائية (المخزن/السيبة)، مقدما صورة مجتمع بلا دولة مركزية، بما يعزز خطاب الحاجة إلى سلطة خارجية منظمة.
2. الإشكاليات البنيوية في هذه الكتابات
نزع التاريخ: تصوير موريتانيا كصحراء بلا حضارة، متجاهلين الإرث المرابطي ودور المنطقة في التاريخ الإسلامي.
التصنيف الإثني الجامد: تقسيم المجتمع إلى (عرب/زنوج) أو (أسياد/عبيد) في قوالب جامدة، دون إدراك لحركية التاريخ.
إقصاء الذات الموريتانية: غياب صوت الفاعلين المحليين، وتحويلهم إلى مجرد موضوعات مراقبة.
3. القراءات الوطنية والبدائل التحررية
عبد الودود ولد الشيخ: في كتاباته مثل Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie (1991)، أعاد النظر في البنية الاجتماعية بعيدا عن التنميط الكولونيالي.
الدكتورإشيب ولد اباتي: في مقالاته حول الهجرة والبنية الاجتماعية، قدم رؤية نقدية تنطلق من الداخل.
المصادر التراثية: مثل المخطوطات والشعر الشنقيطي، والتي تعكس صورة مغايرة لمجتمع متنوع لكنه فاعل تاريخيا وحضاريا.
نحو أنثروبولوجيا تحررية
استعادة السيادة المعرفية: من خلال كتابة تاريخنا بأنفسنا، والانفتاح على أدوات علمية معاصرة دون الوقوع في فخ المركزية الغربية.
أنسنة البحث: جعل الإنسان الموريتاني ذاتا منتجة للمعرفة، لا مجرد موضوع دراسة.
التأصيل القومي: إدراج التجربة الموريتانية في فضاء عربي-إسلامي جامع، يعزز الانتماء الحضاري ويقاوم محاولات التفتيت.
إن نقد الإنتروبولوجيا والتمركز الأوروبي في موريتانيا يفتح أفقا لمشروع تحرري يتجاوز الاستعمار المعرفي. فالمعرفة ليست حيادية، بل إما أن تكون أداة للهيمنة وإما أداة للتحرر. ومن هنا، فإن الحاجة ملحة إلى تأسيس مدرسة بحثية وطنية وقومية تستلهم روح النهضة الناصرية، حيث تصبح المعركة الفكرية جزءا لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني.
وكما قال جمال عبد الناصر: (المعركة الحقيقية هي معركة وعي، فمن يملك وعي الأمة يملك قدرتها على النهوض).
قاسم صالح.