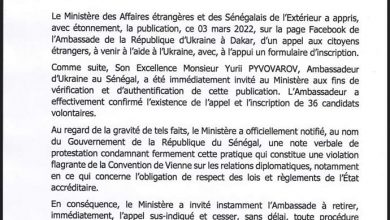نحو قطيعة تاريخية مع الأيديولوجيا العدمية
منذ انتهت الحروب الدينية وانعقد صلح وستفاليا، صارت الدولة الوطنية هي الكيان السياسي الأولي بالرعاية، بل صارت الوطنية ديناً للحداثة، مثلما أصبحت حدود الأوطان مقدسة، فالحدود علامات كأبواب البيوت تحمي حرمات أهلها مثل جلد الإنسان أو جلدة كتاب مقدس، كالإنجيل أو القرآن، جميعها يفتح على باطن الإنسان وعوالم الإيمان، ولذا صار التفريط فيها عاراً لا تبرره الحاجة ولا يمحوه الزمان.
إنه التحول الذي تكرس في القرن التاسع عشر، عندما تم تجريم فكرة الحرب نفسها، ما لم تكن دفاعية، بمواثيق وعهود دولية. أما في القرن العشرين، مع نشوء منظمات دولية مثل عصبة الأمم، ثم الأمم المتحدة، فقد صار ممكناً أن يوضع أمن المجتمعات وسيادة الأوطان في عهدة المجتمع الدولي، ومن ثم انتفت الحاجة الى الحرب، وانتفى «حق الفتح» الذي ألهم حركة الجيوش طيلة آلاف السنين.
وبالقطع لم تتوقف الحرب، بل تكررت سواء في إطار الاحتلال الغربي لجل المجتمعات الشرقية، أو بين دوله المتصارعة على المستعمرات كالحربين الكبريين/ العالميتين. ولكنها في الوقت نفسه لم تعد مشروعة أو طبيعية بل استثنائية ومدانة. ومن ثم أجازف بنفي الجهاد كمفهوم قتالي عسكري تقادم في الزمن، ولم يعد له ما يبرره في الواقع المعاصر، الذي شهد فضلاً عما أسلفناه عن نضج قواعد مستقرة راسخة للعلاقات بين الدول، تقدماً تقنياً وإعلامياً، ونمواً في حريات التعبير والتفكير واستقرارها كمبادئ أساسية في شتى المجتمعات المتمدينة على نحو يتيح إمكانات لا محدودة للتبادل الثقافي والمعرفي، حيث صارت جل الأديان والفلسفات والمعارف متاحة للجميع، من دون حاجة الى قتال لإيصال رسالة الى جماعة محاصرة، تقبع في جغرافية قصية من العالم المعمور، تسيطر عليها فئة حاكمة باغية لا مرد لسلطانها إلا بالقوة مثلما كان الأمر عند انبثاق الرسالة الإسلامية.
ومن ثم ينفتح الباب أمام المسلمين على مفهوم الجهاد «الحضاري»، الذي يتطلب امتلاك الكثير من المعرفة في كل المجالات، وتنمية القدرة على التواصل مع الآخرين، والأهم من ذلك تجسيد المثل العليا الإسلامية التي كرسها النبي محمد في نموذج معاصر للحياة له القدرة على الجذب والإلهام. مثلما ينغلق الباب نفسه من دون مفهوم الجهاد «الحربي» الذي يفتك باجتماعنا العربي في الداخل، كما يدخله في علاقة توتر دموي وخضوع متزايد للخارج. وعلى هذا، فإننا في الحقيقة لا نتنازل عن مفهوم الجهاد بل نختار بين تصورين متمايزين له، يفتح كلاهما الباب على طريق خاص به لحركة الإرادة في التاريخ الإنساني:
على الطريق الأول، حيث الجهاد الحضاري، يسود فهم تاريخي لمفهوم الإرادة، يدرك الطرائق المتعددة لحضورها وفعلها الذي لا يمارس في الفراغ بل من خلال وسائط تزداد تركيباً بفعل حركة التقدم، التي لا يمكن فهمها إلا باعتبارها صيرورة تنظيم وتطوير هذه الوسائط التي يتعامل الإنسان من خلالها مع العالم، بما لا يجعل من سلوكياته مجرد صراعات طائشة يحركها الهوى، بل أفعالاً إنسانية ناضجة تتأسس على قواعد، وتحتضنها مؤسسات تضمن استمرارها واستقلالها. وهنا يجد المسلم نفسه مدفوعاً، بحكم إيمانه، الى أعلى درجات المعرفة طاعة لربه الذي استخلفه على الأرض فإذا به أعلم العلماء. كما يصبح قادراً على استخدام معارفه بأقصى درجات الشجاعة التي توفرها له العناية الإلهية، ويضمنها الشعور بالثقة في الحقيقة الإلهية، فإذا به أشجع الشجعان. ومن ثم يتكامل العقل مع الإرادة، ويصبح المؤمن منتصراً بقوة العلم وشجاعة الإيمان معاً، لا في الحروب فقط بحسب الفهم القاصر للجهاد بل في كل سباق نحو التمدن والتحضر والتقدم والعمران.
أما على الطريق الثاني، حيث الجهاد الحربي، فيسود فهم لاتاريخي يمنح للشجاعة النفسية والرغبة في التضحية البدنية وحدها الدور المركزي في صناعة التاريخ، ولكنه يحرمهما من كافة الوسائط والأبنية الحديثة المفترض لها أن تنظم عملهما، ظناً بأنها، كما كان لدى المسلمين الأوائل، هي الآلية الوحيدة لتغيير العالم، فلا أهمية تذكر للقيم العصرية كالعلم والعقلانية، ولا أهمية أصلاً للمؤسسات الحديثة القادرة على احتضان تلك القيم وتنظيم عملها. ومن ثم يتصور المسلم أن تقواه العميقة سوف تمكنه من هزيمة الدبابة بالسيف أو إسقاط الطائرة من فوق حصان، وهو ما لم يحدث ولن يحدث، فإذا ما انهزم المسلم بدا وكأن الإسلام نفسه قد هُزم، ولأنه لا يريد الاعتراف بهزيمة الإسلام فهو يفضل الموت على مثل هذا الاعتراف، ولذا استحال الجهاد عمليات انتحار عبثية ونزعات تدمير عدمية تنال من وجود المسلم وتشوه الإسلام في آن، حيث يقع التناقض بين الإرادة والعقل، بين الحرية والمعرفة، بين التاريخ والعصر.
وفق الطريق الأول، يقيم الجهاد توازناً دقيقاً بين طرفي الثنائية الوجودية (الحياة – الموت)، بحيث تصبح لحياة المجاهد قيمة في ذاتها، فهي ليست مجرد مدخل الى الموت عبر «الجهاد الأصغر» الذي بات معادلاً معاصراً للانتحار العبثي، بل ركيزة لإعادة صياغة عالم الشهادة الدنيوي/ الواقعي/ الإنساني على النحو الذي يُرضي الله، وهو الجهاد الأكبر وفق قول النبي. ومن ثم فالمسلم الصحيح لا ينزع الى تفضيل الموت من دون تردد أو تعقل، ولكنه يرضي بـالشهادة إيثاراً لله عند الضرورة القصوي. إنه الفهم الذي يحترم الحياة كقيمة في ذاتها، ويجاهد لترقيتها، ومن ثم يدفع المسلم المعاصر الى المشاركة في جماعة تدافع عن حقوق الإنسان أو تدعو لتحرير الأوطان المحتلة أو لتحقيق العدالة الاقتصادية، وليس في تنظيمات إرهابية أو أعمال انتحارية أو الهجوم على دول وشعوب غير مسلمة.
ووفق الطريق الثاني تختل العلاقة بين طرفي تلك الثنائية، الى حد يهدر قيمة الحياة نفسها سواء حياة المجاهد الأصولي، أو حياة المغدورين من ضحاياه. وهكذا يتورط هؤلاء في موقف عدمي؛ إذ يعرفون كيف يموتون في سبيل الله، بغياً على الناس، ولا يعرفون كيف يحيون في سبيله انتصاراً لرسالة الاستخلاف والعمران، ومن ثم يتحول مفهوم الجهاد الى أيديولوجية عدمية، ويصير الإسلام الجهادي عبئاً هائلاً على الإسلام الحضاري.
صلاح سالم- المقال للحياة