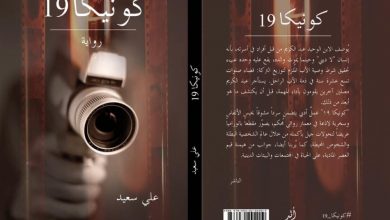“علم الأنواء”… تراث العرب المجهول في الأمطار والرياح والشعر

“مورينيوز” ـ وكالات
فرضت طبيعة الحياة القائمة على الترحال وتتبع مواطن المطر بحثاً عن العشب والكلأ، أن يتقن العرب قديماً بعض العلوم والمعارف؛ خصوصاً عن الأنواء والطقس؛ حيث كانت شمس النهار الملهبة تضطرهم إلى «السُّرى» وهو الرحيل في الليل، فكانوا يقطعون الفيافي الخالية والصحاري البعيدة في الظلام، مهتدين بالقمر أو بالنجوم اللامعة في قبة السماء، حتى لا تضل قوافلهم وتهلك ثروتهم من الإبل عبر كثبان الرمال المتشابهة المتلاحقة كأمواج البحر، والمترامية على مد البصر.
عن هذه المعرفة الفطرية، يدور كتاب «تاريخ علم الأنواء عند العرب» الصادر حديثاً عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ حيث يرصد الباحث الدكتور أحمد عطية الجوانب المختلفة لهذا العلم، متجاوزاً معناه المباشر كأحد العلوم المتفرعة عن علم الفلك، والذي يعنى بالأمطار والرياح في المقام الأول.
وبحسب الباحث، فقد قدمت المعاجم اللغوية تعريفات عدة لمادة «نوأ»، فقد ركز الصاحب بن عباد في كتابه «المحيط في اللغة» على المصطلح، محاولاً تفسير بنيته اللغوية، فقال: «النوء من أنواء النجوم، وهو سقوط نجم بالغداة مع طلوع الفجر وطلوع آخر في حياله في تلك الساعة. وناء الشيء ينوء: أي مال إلى السقوط، ويقال: وما بالبادية أنوأ من فلان: أي أعلم بالأنواء منه». في حين ركز «الجوهري» في تعريفه الوارد بكتاب «الصحاح تاج اللغة» في تعريفه على منازل القمر ومدتها الزمنية، فقال: «والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته». وهو المنحى نفسه تقريباً الذي سلكه الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»، فقال: «وناء النجم: سقط، وناء: طلع».
ويتبين من مطالعة التعريفات السابقة وتأملها، أن أغلب المصادر التي نقلت منها هذه المعاجم اللغوية تعريفاتها لمصطلح «نوء» تدور بين علمي الحديث واللغة، ولم نعرف أن أحداً استمد تعريفه لذلك العلم أو لذلك المصطلح من كتب علم الفلك مثلاً، والذي يعتبر علم الأنواء أحد فروعه لقرون طويلة، ولعل هذا يرجع لتأخر علم الفلك عند المسلمين.
ويكتسب المصطلح بعداً آخر لدى بعض علماء وباحثي الفلك القدامى، مثل أبي إسحاق الفزاري، فلكي الخليفة أبي جعفر المنصور، وأبي معشر البلخي المتوفى 272 هـ، في كتابه «الأمطار والرياح وتغير الأهوية»، بحسب ما ذكره المستشرق كارلو نيللينو، نقلاً عن «الفهرست» للنديم، و«تاريخ الحكماء» للقفطي، مروراً بكوشيار الجيلي، المتوفى 420 هـ، وابن سينا المتوفى 428 هـ، والبيروني المتوفى 440 هـ.
ويخلص المؤلف إلى أن معظم الإنتاج العلمي الذي كتبه هؤلاء الأعلام في مجال علم الفلك والتنجيم لم يصلنا، فالفزاري على سبيل المثال لم يصلنا شيء من كتابيه: «العمل بالإسطرلاب المسطح»، و«العمل بالإسطرلاب». ومن الملاحظ كذلك أن علم الفلك عند المسلمين قد اهتم بالقياس وليس بالرصد، فقد اهتم فلكيو المسلمين بمسألة القياسات المتعددة لحساب المسافة بين الكواكب وحركاتها ومواطن التقائها وطلوعها وغروبها، وما يستتبع ذلك من تغير في الظروف الجوية.
ويذكر المؤلف أن في مخطوط «كتاب السر» لأبي معشر البلخي، نجد حديثاً عن علم الأنواء، فيعقد فصلاً عن تفسير الرياح والأمطار وأسبابهما، وهما لب علم الأنواء، قائلاً: «أما الرياح والأمطار فإنها تكون من البخارين اللطيفين اللذين يرتفعان من البحار والأنهار قبل طلوع الشمس، فقد ترى تلك الساعة والبخار صاعد يشبه الدخان، فأحد البخارين يابس، وصعوده من قطر الأرض تنشأ منه الرياح ذات الرعود والبروق والهبوب والصواعق والشرر، وما يشبه هذا النحو. والبخار الثاني رطب، وصعوده من جوهر الرطوبة، ومنه ينشق الضباب والجليد والثلوج والأمطار».
وهذا التفسير الذي قدمه البلخي قريب جداً من الدائرة التي يهتم بها علم الأنواء عند العرب، فهو يربط حركة الرياح والأمطار بسقوط النجوم وطلوعها، ما يؤكد وجود صدى لعلم الأنواء في تلك المؤلفات التي كتبت في علم الفلك في تلك الفترة المبكرة من تاريخ حضارتنا الإسلامية، وهو الأمر الذي يؤكد أن هذه المؤلفات تعد من المصادر الحقيقية لعلم الأنواء عند العرب.
ويذهب جورجي زيدان في كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية»، إلى أن المراد بالأنواء عندهم ما يقابل علم الظواهر المذكورة إلى طلوع الكواكب أو غروبها، ولذلك كان علم الأنواء فرعاً من علم النجوم، وكانوا يسمون طلوع المنزلة نوءها، أي نهوضها، وسموا تأثير الطلوع بارحاً وتأثير السقوط نوءاً. ومن ذلك قول أحدهم في قصيدة:
«والدهر فاعلم كله أرباعُ
لكل ربع واحدٌ أسباعُ
وكل سبع لطلوع كوكبِ
ونوءُ نجم ساقط في المغرب»
وجاء في كتاب ابن قتيبة «الأنواء في مواسم العرب»: «من خواص الجنوب أنها تثير البحر حتى تسوده، وتظهر كل ندى كامن في بطن الأرض حتى تلين الأرض، وإذا صادفت بناء بُني في الشتاء أظهرت نداه وجعلته يتناثر، كما أنها تطيل الثوب القصير، ويضيق لها الخاتم في الإصبع. تقول العرب إن الجنوب قالت للشمال إن لي عليك فضلاً، أنا أسري، أي أسير بالليل، وأنت لا تسرين، فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري».
ويعد كتاب «الأنواء» لأبي يحيى محمد بن عبد الله كناسة الكوفي، المتوفى 207 هـ، من المؤلفات المبكرة التي ألفت حول علم الأنواء عند العرب، والتي لو وصلت إلينا -بحسب المؤلف- لاستطعنا من خلالها أن نرصد طبيعة البدايات الأولى للتأليف في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ تراثنا العربي.
وقد أورد ابن قتيبة عن ابن كناسة ثمانية مواضع للقمر والكواكب على علاقة وثيقة بالرياح والأمطار، ولكن هناك أمراً مهماً آخر تشير إليه تلك النقول الموجودة عن ابن قتيبة ونسبها إلى ابن كناسة، وهي أنها مذهب على مذهب العرب في معرفة علم الأنواء، وهي معرفة عملية قائمة على مشاهدة السماء أو على عملية الرصد لا القياس الذي مثل علامة كبرى في علم الفلك عند علماء المسلمين فيما بعد.
ويكاد يكون كتاب «الأنواء في مواسم العرب» لابن قتيبة الدينوري، المتوفى 276 هـ، كتاباً في علم اللغة؛ إلا أن المساحة التي شملها في حديثه من علم الأنواء أوسع بكثير، ما يدل على أن هذا العلم قد شغل مساحة لا بأس بها من العقلية العربية.
يبدأ ابن قتيبة بعد بيان المقدمة التي وضح فيها الغرض من تأليفه هذا، بذكر منازل القمر، وهو أمر مرتبط تمام الارتباط بقضية الأنواء؛ حيث يقول: «ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً، ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها، من مهله إلى ثمانٍ وعشرين ليلة، فإن كان الشهر تسعاً وعشرين استسر ليلة ثمانٍ وعشرين ليلة تمضي من الشهر، وفي السِّرار نازل بالمنازل، فإذا بدا من الشهر الثاني هلالاً طلع وقد قطع ليلة السِّرار منزلاً من هذه المنازل». ثم يذكر فقرة مهمة تعكس بحق أن معارف العرب التي اعتمد عليها ابن قتيبة من علم النجوم وما يرتبط بها من أنواء، قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، مع الأخذ بالحسبان أن العرب لم يكن لديهم أجهزة رصد، وإنما كانوا يعتمدون على العين المجردة. يقول ابن قتيبة: «وهذه المنازل الثمانية والعشرون تبدو للناظر منها في السماء أربعة عشر منزلاً، وتخفى عنه أربعة عشر منزلاً، وكذلك البروج وهي اثنا عشر برجاً، كل برج منزلان وثلث من هذه الثمانية والعشرين، وإنما يبدو لك منها ستة بروج، وهذا يدل على أن الظاهر لنا من السماء لأبصارنا نصفها، والله أعلم».
يقع الكتاب في 163 صفحة من القطع الكبير، ورغم طرافة وتشويق الموضوع فإن التزام المؤلف بالمنهج العلمي الأكاديمي جعل لغته جافة أحياناً.
الشرق الأوسط .