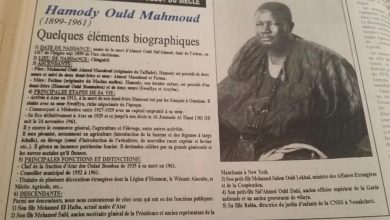عن قلادة الزمرّد والأبدية الساحرة وأشياء أخرى / د. بدي ابنو

ـ1ـ
بوسطن، فاتح مايو الماضي. سمعتُ مصادفة أنّ المدينة التي تدلّل نفسَها بأنها مهبط التحرّر و”التي بارتي Tea Party” (اندلاع ثورة الاستقلال عن بريطانيا سنة 1773، وقد ظهرتْ في بداية عهد إدارة أوباما حركة حريانية تُطلق على نفسها أيضا هذا الاسم) تحتفل هذه الأيام بمرور عقد ونصف على تشييدِ تذكاريات لنسائها. تعتزّ بأنها أخيرا تجاسرتْ على تذكّر منْ توهمتْ أنّ النسيان التهمهنّ.
كنتُ أريد في البداية أنْ أحترم ذلك اليوم نصيحة أحد الزملاء وأذهب معه إلى مزاريْ الشاعر رالف أميرسون والشاعرة لويزا ألكوت شمالي غربي بوسطن. ولكن للتذكاريات الجديدة أولوية عندي ولوسط المدينة في هذا الفصل إغواؤه. يبدو إيقاع الفصل مهيمنا. يصافحُ الربيع نفسَه ويكشف ملامحَه لملامحِه. الطيور والسناجب تتدلّلُ في متنزهات قلادة الزمرّد المتهادية جنب نهر تشارلز. ورائحة الربيع وألوانه تُنافسُ بعضها على ضفتيه. فيها يفشل أحيانا صخب اللامعنى ونزق الزحمة وغطرسة العمارات في حجب ما يتخفّى في زخّات النوافير من أبدية ساحرة وصامتة.
أخيراً شيدتْ بوسطون تذكاريات لثلاث بينهن الشاعرة فيليس ويتلي، تلك المسكينة التي نقلتها أقدار التجارة الثلاثية من الماء إلى الماء، من الضفاف الصنهاجية إلى ضفاف نهر الملِك المقتول. محتملٌ أن لا يكون السهروردي راضيا لا عن الملك تشارلز ولا عن التسمية. حين اختُطفتْ ووُضعتْ في الباخرة بميناء سينلوي سنة 1761 لتستأنف أو لتتابعَ رحلة “الأسماء المتغيرة” لمْ تكن قد جاوزت السابعة أو الثامنة من عمرها. كانت الرحلة حينها طبعاً بين شاطئي الأطلسي ـ أو بحر الظلمات كما سمّاه القدماء ـ رحلة الألم الأكبر.
ما اسمها الأصلي؟ بين الشاطئين ضاعتْ الذاكرة. استُقدمتْ المسكينة من سينلوي إلى بوسطن في باخرة اسمها فيليس. ستُختَصرُ هويتُها في البداية في هذه الباخرة سيئة السمعة وفي عائلة ويتلي التي تبنّتْها بثمن يوسفي في بوسطن. لم يعد لها اسم آخر. وإن كان التمعّن في قسماتها عبر الرسوم الناجية، بالنسبة لمن يعرف قليلا بندقية افريقيا وضفافها، يسمح بسهولة بتوقع اسمها الأصلي بين قائمة قليلة من الأسماء التي تصافح لساني النهر والمحيط.
نشأتْ في ضفاف نهر السنغال وأغلب الظن عندي لأسباب متعدّدة أنها ترعرعتْ في أسرة دينية متعلّمة. في ديوانها قصيدةٌ مشهورة عن استقدامها من إفريقيا إلى أمريكا (On Being Brought From Africa to America) كتبتْ فيها أنها جاءتْ من بلد لم يَعرفْ الدين أو من “بلدي الجاهلي” (my Pagan land)، وهي عبارة تجد تفسيرها سياقياً ولكن أيضا قد لا يستهان بالحدْس الشعري الذي تَصْدُر عنه.
ليس للاسترقاق ما يخفّف من حقيقته المظلمة. ومع ذلك فعائلة ويتلي في بوسطون عائلة متعلمة وتتميز كما يُروى بمستوى من الانفتاح بمعايير تلك الحقبة. وقد كشفتْ عن قدْرٍ غير معتاد حينها من التعاطف مع فيليس. بعْضُ المصادر تذهب أبعد من ذلك وتقول إن الطفلة التي وُلدتْ في الضفاف الصنهاجية صارت تقريبا فردا من العائلة لأنها ذكّرتْهم بحكم عمرها وقامتها بابنة لهم تُوفيتْ عشية وصول الباخرة البطيئة. واضح على الأقل أنّ عائلة ويتلي فوجئتْ بالاهتمامات الدراسية للطفلة الافريقية فساعدوها على مواصلة مسيرتها التعليمية. ويُروى عادة أنها أجادت بسرعة اللاتينية والإغريقية فضلا عن الانجليزية.
عندما اشتهرتْ فيليس كشاعرة واستقدِمتْ إلى بريطانيا، صادفَ الأمر وجودَ فولتير لاجئا في لندن فسمع عنها واطَّلع على قصائدها. قال عنها بكثير من الحماس إنها أثبتتْ أن افريقيا قادرة على كتابة الشعر. احتفاء يكشف عمقَ الأحكام المسبقة العرقية أوالثقافية التي كانت سائدة وربما لم تختف إلا جزئياً. كان ذلك في الفترة نفسها التي وصف فيها فولتير كاتباً افريقياً آخر (ابرهام المعروف بهانبل، جد الشاعر الروسي بوشكين) بنجم الأنوار السمراء. فـ”أنوار” القرن الثامن عشر لمْ تتخيل أن افريقيا تنجب أدبا وفكراً. أما أنْ تكتب امرأة، افريقية أو غير افريقية، شعرا فهو أمر يمثّلُ بحدّ ذاته ثورةً في عقل الحداثة الأولى (رغم مئات الأقلام النسائية التي عرفتْها الثقافات السابقة). ذاكرة الثقافة المهيمنة تجاه ما يغايرها غالباً ضعيفة. وإلى حدّ ما لم يكن في الحقيقة عصر الأنوار بعيدا عن بحر االظلمات. يجمعهما أفق ماورائي من الإِرداف أو الأكسيمورون. بديهي أنّ التحيزات أو الأحكام المسبقة ليستْ خاصة بثقافة معينة. وباستعمال عبارات غير بعيدة عن تلك التي استعملها ديكارت عن العقل فإن العنصرية ربما تكون أكثر الأشياء انتشارا وتوزيعاً تكافئياً بين البشر بمختلف عيناتهم.
أشياء كثيرة حدثتْ في حياة فيليس ويتلي القصيرة (توفيتْ تحتَ وطأة الفقر والمرض وعمرها 31 سنة) قبل أن تصبحَ شاعرة الثورة الأمريكية. أشياء أهمّها أنها تحرّرت بشعْرها (تخلّصت من الاسترقاق مباشرة بعد صدور ديوانها سنة 1773، أي سنة اندلاع الثورة) وأنها حاولت تحطيم الصورة النمطية التي كانت تُراد لها. أصبحت ثالث امرأة تُنشر أعمالها الأدبية في العلم الجديد وأول شاعرة أمريكية من أصل افريقي. وليس غريبا أن القرن الموالي سيعرف في بوسطن نهضة علمية وأدبية قادتها السيدات على كلّ الصعد. بل أصبحتْ المدينة معقل القيادات النسوية وأدبيات التحرّر والانعتاق. وهو ربما ما عنيه نصب التذكاريات بهذه النظرات التأملّية المتبادلة اللافتة بين فيليس ويتلي ولسي ستون وآبيغاي آدامس. بنوع من التفاؤل المفرط أو من الوصية التعبوية اللصيقة بحماس المرحلة قالت لسي ستون وهي تعيش أيامها الأخيرة في نهاية القرن التاسع عشر: “من الآن فصاعدا أصبحتْ أوراق شجرة المعرفة للنساء، ولشفاء الأمم“.
ـ2ـ
“أثينا أمريكا”؟ ربما لمْ يعد هذا اللقبُ يعني شيئا لسكاّنها باستثناء مرتادي بعض الأقسام الهادئة في بي يو أو هارفرد أو أم آي تي. تسألني بائية البرعي عن “رامة”. قلتُ : ما ذا بقي من أثينا فلاطون والمدن التي تتحدّث عنها سرديات شرق المتوسّط وجنوبه حتى تفتخر بها مدن العالم الجديد ؟ منذ قرن ونصف أنشدَ هنا أمرسون بلغة نبوئية في قصيدته التي سمّاها “نشيد بوسطن” : ” أجعَلُ من كل مخلوق سلعةً جيدةً للتدفق”. ولكنّ المدينة حافظتْ على بعض كرامتها في وجه السلعة، منذ فيليس ويتلي إلى مارغريت فيلير وأدغار ألان بو وإيميلي ديكنسون و رالف أمرسون ولويزا ألكوت إوولت وايتمان إلى جبران إلى آن سيكستن وسنود غراس إلخ.
يُروى أنّ مدينة بوسطن الأصلية في إنجلترا ـ التي استعارت منها بوسطن ماساشوستس اسمها ـ هي تحريف لاسم القديس بوتولف الذي يُفترض أنه مؤسّسها. بوتولف يُلقّب أيضا بقديس الراحلين. مدن كثيرة في العالم الجديد تحمل هذا الاسم ويدّعي مؤسسوها أنهم قادمون من بوسطون البريطانية. بسخريته اللاذعة كتب ميخائيل نعيمة في كتابه عن جبران أن “الأصلاء” في العالم الجديد هم الذين “نزحوا أولا من بلاد الانكليز وهولاندة إلى أمريكا الشمالية. وفي مقدمتهم “الحجاج” الذين قطعوا المحيط الأطلنطيكي على مركب شراعي يدعى “مايفلور” واستعمروا مقاطعة “انكلترا الجديدة” (…) وقد تضخّم عدد هؤلاء “الأشراف” ـ وبالأخصّ في بوسطن وجوارها ـ إلى حدّ أنّ الأسطول الانكليزي بمجموعه لا يكاد يُقلّ في عام 1934 ما أقلّه ذلك المركب الشراعي في عام 1620 من أسلاف “شرفاء” أمريكا اليوم ـ إذا صدق ادعاء كل المدّعين“.
تحترق الكلمات الساذجة وهي تلوك أشياء وهمية عن ماض بلا حاضر وحاضر بلا ماض. الحكمة يمانية : “وكمْ من سميٍ ليس مثل سميه وإنْ كان يدعى باسمه فيجيب” (ربما استحضَرَها المتصوفُ الكبير اقتباسًا لأنّها وردتْ قبْله في ديوان الحماسة لأبي تمّام وربّما وردتْ بصيغ أخرى في مصادر أخرى). أثينا القديمة أسطورة أكثر مما هي حقيقة ولعلّها بمعنى ما لمْ تكن يوماً سوى أسطورة بينما ما زالت بوسطن حقيقة أكثر مما هي أسطورة. أو ما تزال حقيقتها تنافس أسطورتها. شعوب كثيرة تعيش تلك المأساة، مأساة الاغتراب في ماض وهمي. وأخرى تعيشها بالوكالة : “ولِنارِ المِرّيخِ مِن حَدَثانِ الدّهْــــ ــــرِ مُطْفٍ وَإنْ عَلَتْ في اتّقادِ” (المعرّي) وزاد الراوي : وأخرى لمْ تعرفْ بعدُ لونَ جبينها تعيدُ ترتيب السرد.
ـ3ـ
لعبت السيدات دورا كبيراً في إبقاء قدّاس الأقداس الشعرية حاضرا بدرجة ما في بوسطن، في إنشاء المؤسسات العلمية والفنية والإنفاق عليها. تشهد لها هذه الرسوم الجدارية وهذا الجمال المتدفّق وهذه النوافير العروسية المتباهية والمعابد المعرفية التي ظهر أغلبها تزامنيا في أواخر القرن التاسع عشر. هذا الصنوبر العنيد ما يزال ينافس هذه العمارات ذات الطراز المعماري رغم ان وجهته الارض بينهما هي السماء. ولكنه يظل سماويا أكثر منها.
ماري هاسكل “الملاك الحارس” لجبران لم تكن ثرية على ما يبدو. ولكنها أضافت إلى ثروتها المتوسطة قدرة على بذل جهدها ووقتها لمدّ يد العون. لديها نوع من التصوف أو شبه الرهبنة في التفاني في خدمة الآخرين.
مضت مائة وسبع سنوات على الساعات التي كان فيها جبران يقرأ لها في هذا المبنى قصيدة “كتاب ثيل” الذي ألّفه وليام بلاك تزامنا مع الثورة الفرنسية. كان جبران يتساءل مع بلاك “لماذا يتلاشى السدر مع الماء ؟” للأسئلة الأولى دائما رغم الألم عنفوان البدايات وطعمها العذب.
كتبَ جبران هجائيته ضدّ الأنصاف وهو يغرف ربّما مفردات بلاك من ورومانسيات المتعالين ويَسبح في محبته للنار والثلج كفرعين لأصل واحد كما كتب في إحدى رسائله إلى مي زيادة.
تصادف وصول جبران صغيراً سنة 1895 إلى بوسطن مع افتتاح مكتبتها العمومية الجديدة. فمنحتْه رغم فقره المدقع فضاء مناسبا. وقد أهدى لها لا حقا كتبا مع عبارة أنه أُعينَ كثيرا فيحب أْنْ يعين بدوره. نُقشتْ هذه العبارة الأخيرة على اللوحة التذكارية التي نُصبتْ له سنة 2008 قبالة المكتبة على بعد أمتار من نصب فيليس ويتلي في إحالة قد لا تجهل نفسها إلى بائية امرئ القيس. أما إشارة الإعانة فتتجه غالباً إلى ماري هاسكل.
يستعيد المبنى صوت هسكل وهي تمنح جبران إحدى نبوءاتها: “يوما ما سيُقرأ صمتُك مع كتابتك. وجوانبك الحالكة ستصبح جزءا لا يتجزأ من النور” كتب لها يوما وهو بفضل سخائها يقيم في الضفة اليسرى من نهر السين: ” سيأتي اليوم الذي أستطيع أن أقول لقد أصبحت فنانا بفضل ماري هسكل.”
تغير لون المبنى وتجدّد ولكن شكله العام بقي كما هو. تماما كما يظهر في الصور منذ أكثر من قرن. وقفتُ أتأمّل وأنا أحاول أن أتفادى لفت الانتباه. فالحي صامت وتقريبا خال من المارّة. وما كان يوما مدرسة هاسكل للبنات لم يعد سوى بيت سكني عاد ككل البيوت المجاورة.
طبعاً رحلتْ المدرسة منذ قرن ورحلتْ معها تفاصيلها الطريفة. وأنجبتْ الخاتم الذي صمّمه جبران بتلك المناسبة (اندماجها سنة 1918 مع مدرسة كامبريدج للبنات لتصبح مدرسة كامبريدج هاسكل، لا حقا مدرجة كامبردج في ويستن التي تتمتّع حاليا بشهرة عالمية) في صورة زهرة بيدٍ مفتوحة. لم تذبل الزهرة ولم تنقبض اليد.
الأيام تخفي في ثناياها تفاصيل غامضة وأسرار أليمة. “لماذا يتلاشى هؤلاء الأطفال في الربيع؟ الولادة والابتسامة فالسقوط.” (وليام بلاك)
المدن غالبا تسخر من مؤسسيها. وتسخر أكثر من الأجيال التي تتعاقب فيها. طموحات البشر وحماقاتهم الصغيرة والكبيرة وأشياؤهم المعلنة والمخفية هي كما هي. هل يتعلم جيل من جيل إلا تكرارها؟ ولكن شيئا ما يحفظ في بوسطن في وجه الماكينة الرأسمالية بعضَ حدس القصيدة، ، بعض روح المتعالين وبعض حسّ الاعترافيين. وفيما عدا ذلك فقد دار الزمن واستدار المعنى.