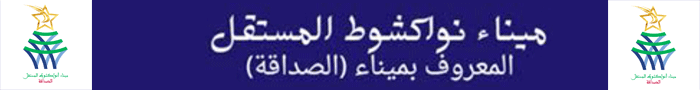أخبار وتقارير
الأمة بين مطرقة الهوان وسندان التبعية: قراءة في واقع الأمة الإسلامية والعربية / كبرياء رجل

كأن هذه الأمة قُدّر لها أن تسير فوق جمر التاريخ، تتناوب عليها رياح الانكسار وأعاصير الفراغ، حتى بدت اليوم كمن فقد البوصلة، تائهًا بين أطلال مجد قديم وأوهام حاضر هشّ، بينما ظلت تمضي مثقلة بأوجاعها، تتلفت خلفها أكثر مما تنظر أمامها.
واقع الأمة الإسلامية والعربية اليوم لا يخفى على بصير؛ فهو مشهد بالغ التعقيد، يختلط فيه السياسي بالثقافي، وتتماوج فيه خيوط الضعف بين ما هو موروث وما هو مكتسب. ولسنا أمام مجرد أزمة اقتصادية أو سياسية طارئة، بل أمام حالة من الانهيار الشامل الذي ضرب أعماق البنية الفكرية والاجتماعية للأمة، حتى صرنا أمام حالة من فقدان الهوية والقرار معًا.
وحين نستنطق التاريخ، نرى أن هذه الأمة عرفت مراحل أشدّ إيلامًا مما نعيشه اليوم، لكنها دائمًا ما استطاعت أن تعيد ترتيب صفوفها. فها هي بغداد تسقط في القرن الثالث عشر على يد الغزاة، في واحدة من أكثر لحظات التاريخ الإسلامي دموية، ليس فقط بسبب الهزيمة العسكرية، بل لأن الأمة يومها كانت تعيش حالة من التشتت والانشغال عن قضاياها المصيرية. وكذلك الأندلس، التي لم تسقط فجأة، بل ذبلت ببطء تحت وطأة الخلافات والصراعات الداخلية، حتى سلّمت مفاتيحها طوعًا لمن لم يكن يملك القوة لانتزاعها بالقوة.
وفي العصر الحديث، وجدنا الدولة العثمانية، آخر مظاهر الوحدة السياسية، تنزلق شيئًا فشيئًا نحو التفكك، حتى صارت تعرف بـ”الرجل المريض”، علامة على ضعف داخلي عميق، تجاوز حدود السياسة ليطال العقل والروح. أما الأمة العربية، فقد عرفت في القرن العشرين هزائم كبرى، كانت نكسة 1967 ذروتها، حيث بدا كل شيء يتهاوى: الجغرافيا، الثقة، وحتى الأحلام.
قال ابن خلدون: “الغاية من الاجتماع الإنساني حفظ النوع البشري”، وهذه الغاية لا تتحقق في أمة فقدت بوصلتها، لأن الظلم – كما قال أيضًا – “مؤذن بخراب العمران”، وما نراه من خراب هو انعكاس لانهيار العدالة في مفاصل السياسة والمجتمع معًا.
غير أن الأخطر من كل ذلك هو ما خلّفته هذه النكبات من آثار على مستوى الوعي الجمعي؛ إذ رسّخت في النفوس فكرة العجز، وعززت التبعية للآخر، ليس فقط في السلاح والاقتصاد، بل في الفكر ونمط الحياة. وهو ما حذر منه مالك بن نبي بقوله: “القابلية للاستعمار أخطر من الاستعمار ذاته، لأنها تمهد له وتبرره.” وهكذا وجدنا أنفسنا أمام جيل بات يرى النموذج الغربي معيارًا للتقدم، حتى صدّق بعض النخب أن الأمة لا تنهض إلا على خطى الآخرين، وهو ما وصفه إدوارد سعيد بمرارة حين قال: “المشكلة الكبرى ليست أن الغرب أقوى من الشرق، بل أن الشرق يصدّق دائمًا أن قوته لا تقوم إلا بتقليد الغرب.”
وفي قلب هذا المشهد البائس، يبدو المشروع الحضاري غائبًا تمامًا. نحن أمة بلا مشروع واضح، بلا بوصلة تحدد المسار، تمامًا كما وصف محمد إقبال: “الأمم تولد في عقول المفكرين، وتموت في أيدي الساسة.” وهذا الموت الرمزي لا يعني الفناء التام، بل هو أشبه بغياب الروح عن الجسد، جسد الأمة الذي أثقله الاستبداد والجمود. وقد أشار عبد الرحمن الكواكبي إلى هذه العلاقة الخطيرة بين الطغيان والتراجع الحضاري بقوله: “ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقامًا ذا علاقة بالله.”
ورغم كل هذا، فإن التاريخ يمنح دائمًا نوافذ صغيرة للأمل. فحين طوت الأندلس آخر صفحاتها، بزغ نجم الدولة العثمانية، وكأن الأمة، كما قال ابن خلدون، تملك دورة حياة تتجدد كلما أصابها الضعف. وكذلك حين سقطت بغداد، لم تلبث أن نهضت قوى جديدة على الأطراف، تثبت أن الأمة لا تموت، بل تمرض.
إن نهضة الأمة اليوم لا تكون بتغيير الوجوه أو الاكتفاء بخطب موسمية، بل تبدأ من إعادة بناء الإنسان. وكما قال جمال الدين الأفغاني: “الأمم لا تنهض إلا بالعلم، وإذا أُهملت العلوم، تأخرت الأمة، وذلت، وتلاشت شخصيتها.” فالعلم والوعي هما السلاح الحقيقي لإعادة بناء المجد المهدور. وقد صدق ابن المقفع حين قال: “إذا أردت أن تعرف أخلاق أمة فانظر إلى علمائها.”
وبينما تغرق بعض الأنظمة في التسلط وتبديد الموارد، يبقى صوت الضمير الإنساني يذكّرنا، كما قال محمد عبده: “ليست الأمم بمساحة أرضها ولا بعدد سكانها، بل بكرامتها ومكانتها بين الأمم.”
إن الحاجة اليوم ملحّة إلى يقظة كبرى تعيد الأمة إلى روحها الأولى، تلك الروح التي تجعلها قادرة على الإمساك بزمام مصيرها بثقة واقتدار. وكما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.” فالإرادة الصادقة وحدها هي القادرة على تحويل الجراح إلى قوة، والانكسار إلى نهوض.
وفي النهاية، يبقى القول حجة علينا:
“ومن يتهيب صعود الجبال… يعش أبد الدهر بين الحفر.”
المصدر: الفيسبوك – صفحة كبرياء رجل.
واقع الأمة الإسلامية والعربية اليوم لا يخفى على بصير؛ فهو مشهد بالغ التعقيد، يختلط فيه السياسي بالثقافي، وتتماوج فيه خيوط الضعف بين ما هو موروث وما هو مكتسب. ولسنا أمام مجرد أزمة اقتصادية أو سياسية طارئة، بل أمام حالة من الانهيار الشامل الذي ضرب أعماق البنية الفكرية والاجتماعية للأمة، حتى صرنا أمام حالة من فقدان الهوية والقرار معًا.
وحين نستنطق التاريخ، نرى أن هذه الأمة عرفت مراحل أشدّ إيلامًا مما نعيشه اليوم، لكنها دائمًا ما استطاعت أن تعيد ترتيب صفوفها. فها هي بغداد تسقط في القرن الثالث عشر على يد الغزاة، في واحدة من أكثر لحظات التاريخ الإسلامي دموية، ليس فقط بسبب الهزيمة العسكرية، بل لأن الأمة يومها كانت تعيش حالة من التشتت والانشغال عن قضاياها المصيرية. وكذلك الأندلس، التي لم تسقط فجأة، بل ذبلت ببطء تحت وطأة الخلافات والصراعات الداخلية، حتى سلّمت مفاتيحها طوعًا لمن لم يكن يملك القوة لانتزاعها بالقوة.
وفي العصر الحديث، وجدنا الدولة العثمانية، آخر مظاهر الوحدة السياسية، تنزلق شيئًا فشيئًا نحو التفكك، حتى صارت تعرف بـ”الرجل المريض”، علامة على ضعف داخلي عميق، تجاوز حدود السياسة ليطال العقل والروح. أما الأمة العربية، فقد عرفت في القرن العشرين هزائم كبرى، كانت نكسة 1967 ذروتها، حيث بدا كل شيء يتهاوى: الجغرافيا، الثقة، وحتى الأحلام.
قال ابن خلدون: “الغاية من الاجتماع الإنساني حفظ النوع البشري”، وهذه الغاية لا تتحقق في أمة فقدت بوصلتها، لأن الظلم – كما قال أيضًا – “مؤذن بخراب العمران”، وما نراه من خراب هو انعكاس لانهيار العدالة في مفاصل السياسة والمجتمع معًا.
غير أن الأخطر من كل ذلك هو ما خلّفته هذه النكبات من آثار على مستوى الوعي الجمعي؛ إذ رسّخت في النفوس فكرة العجز، وعززت التبعية للآخر، ليس فقط في السلاح والاقتصاد، بل في الفكر ونمط الحياة. وهو ما حذر منه مالك بن نبي بقوله: “القابلية للاستعمار أخطر من الاستعمار ذاته، لأنها تمهد له وتبرره.” وهكذا وجدنا أنفسنا أمام جيل بات يرى النموذج الغربي معيارًا للتقدم، حتى صدّق بعض النخب أن الأمة لا تنهض إلا على خطى الآخرين، وهو ما وصفه إدوارد سعيد بمرارة حين قال: “المشكلة الكبرى ليست أن الغرب أقوى من الشرق، بل أن الشرق يصدّق دائمًا أن قوته لا تقوم إلا بتقليد الغرب.”
وفي قلب هذا المشهد البائس، يبدو المشروع الحضاري غائبًا تمامًا. نحن أمة بلا مشروع واضح، بلا بوصلة تحدد المسار، تمامًا كما وصف محمد إقبال: “الأمم تولد في عقول المفكرين، وتموت في أيدي الساسة.” وهذا الموت الرمزي لا يعني الفناء التام، بل هو أشبه بغياب الروح عن الجسد، جسد الأمة الذي أثقله الاستبداد والجمود. وقد أشار عبد الرحمن الكواكبي إلى هذه العلاقة الخطيرة بين الطغيان والتراجع الحضاري بقوله: “ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقامًا ذا علاقة بالله.”
ورغم كل هذا، فإن التاريخ يمنح دائمًا نوافذ صغيرة للأمل. فحين طوت الأندلس آخر صفحاتها، بزغ نجم الدولة العثمانية، وكأن الأمة، كما قال ابن خلدون، تملك دورة حياة تتجدد كلما أصابها الضعف. وكذلك حين سقطت بغداد، لم تلبث أن نهضت قوى جديدة على الأطراف، تثبت أن الأمة لا تموت، بل تمرض.
إن نهضة الأمة اليوم لا تكون بتغيير الوجوه أو الاكتفاء بخطب موسمية، بل تبدأ من إعادة بناء الإنسان. وكما قال جمال الدين الأفغاني: “الأمم لا تنهض إلا بالعلم، وإذا أُهملت العلوم، تأخرت الأمة، وذلت، وتلاشت شخصيتها.” فالعلم والوعي هما السلاح الحقيقي لإعادة بناء المجد المهدور. وقد صدق ابن المقفع حين قال: “إذا أردت أن تعرف أخلاق أمة فانظر إلى علمائها.”
وبينما تغرق بعض الأنظمة في التسلط وتبديد الموارد، يبقى صوت الضمير الإنساني يذكّرنا، كما قال محمد عبده: “ليست الأمم بمساحة أرضها ولا بعدد سكانها، بل بكرامتها ومكانتها بين الأمم.”
إن الحاجة اليوم ملحّة إلى يقظة كبرى تعيد الأمة إلى روحها الأولى، تلك الروح التي تجعلها قادرة على الإمساك بزمام مصيرها بثقة واقتدار. وكما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.” فالإرادة الصادقة وحدها هي القادرة على تحويل الجراح إلى قوة، والانكسار إلى نهوض.
وفي النهاية، يبقى القول حجة علينا:
“ومن يتهيب صعود الجبال… يعش أبد الدهر بين الحفر.”
المصدر: الفيسبوك – صفحة كبرياء رجل.