الرمل. والبحر.. والرحيل (3 من 3): لنا أن نحلم رغم قسوة الواقع/محمد سعيد همدي
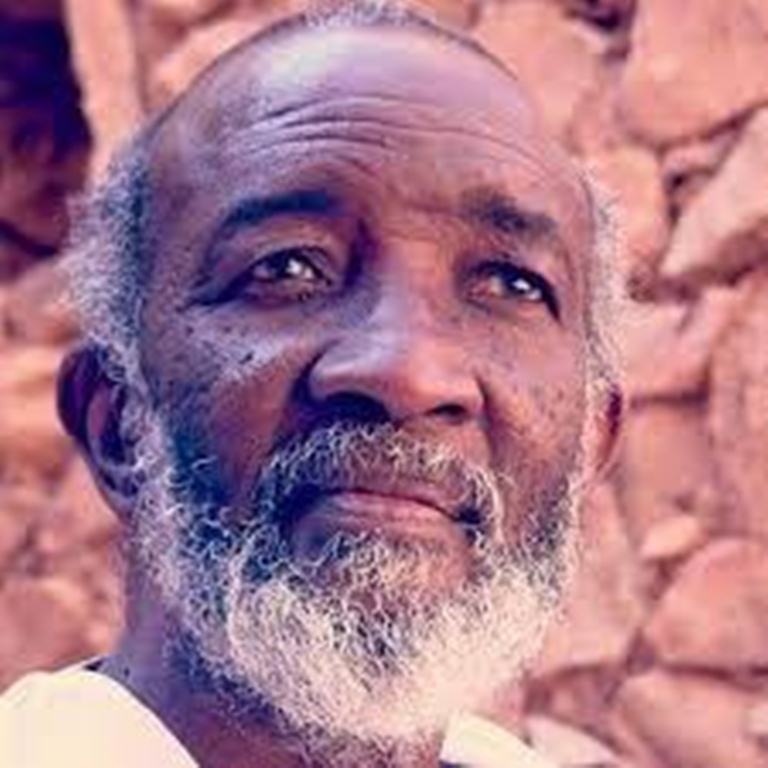
في الحلقة الأولى من هذا المقال تناول الكاتب محمد سعيد ولد همدي بنية المجتمع الموريتاني التقليدي والتراتبية فيه. والتواطؤ بين الزوايا والمحاربين من أجل السيطرة. ودخل الكاتب إلى موضوع العبودية من خلال أسطورة “حام” هذا الرجل الذي هو “جد العبيد” حسب الأسطورة والذي جر عليهم سواد البشرة بعدم اهتمامه بالعلم وترك المطر يغسل لوحه على جسده (تواطؤ السيف والقلم.. لعنة حام) وفي الحلقة الثانية تحدث عن الاستعمار ودوره في تحطيم البنية القديمة: ” مذلة السيف وانتهازية القلم”. وفي الحلقة الأخيرة يتناول الواقع الصعب ومشروعية الأحلام:
…. وبما أن ظاهرة النزوح الريفي مصاحبة للجفاف بكل أشكاله، فبإمكاننا أن نلاحظ أشكالا من النزوح الريفي قديمة أيضا. ومع ذلك فإنه لم يصبح ظاهرة خطرة إلا بعد تدهور الظروف المناخية وتتابع الهزات الاجتماعية الناتجة عن العدوان الاستعماري وعن خيبة الآمال التي علقت على “الاستقلال”.
هذه الأزمات الطبيعية والاجتماعية والتاريخية، هي التي جعلت النزوح خطرا اجتماعيا حقيقيا. ففي الأرياف يتم إخلاء قرى بكاملها وترك البساتين للبوار. ويتوجه الفلاحون، الذين لم تقم الدولة بأي شيء لتشجيعهم على الاستقرار.. يتوجهون إلى العاصمة الإقليمية كمرحلة أولى قبل النزوح النهائي إلى نواكشوط.
وعند وصول الريفيين إلى العاصمة الإقليمية، يكون السكان الأصليون لهذه العاصمة قد انتقلوا إلى انواكشوط بحجة البحث عن قطعة أرضية أو بهدف إدخال إحدى بنات الأسرة في الثانوية.
وبفعل هذه الهجرات العشوائية يتضخم الحجم السكاني لمدينة نواكشوط بصورة انفجارية .
اذكر أن صديقا من “المتفائلين قال لي في أحد الأيام: “من حسنات هذه الهجرة ما ستؤدي إليه من القضاء على القبلية”.
وكنت أريد أن أقول لهذا الصديق: “إن هذه الهجرة لم تقض إلا على الجوانب الإيجابية في القبيلة” فإحساس قاطن انواكشوط بفرديته وانفصاله عن الكيان القبلي التقليدي قد أدى إلى شعوره بالتحلل من القواعد الأخلاقية التي كانت القبيلة تفرضها. وبذلك خلا الجو لضعاف النفوس كي يستجيبوا لنداء الغرائز السافلة، فانتشرت الممارسات الدنيئة (التلصص، الإدمان، الدعارة…إلخ..).
وهكذا اكتملت حلقات سيطرة الجفاف هذا الغول المتعدد الرؤوس.. اكتملت هذه الحلقات بتدهور الوسط الطبيعي، كما تشهد بذلك الغابات اليابسة والكثبان الزاحفة والحيوانات السائرة في طريق الانقراض. أما النهر فإنه يوشك أن ينضب بعد أن بلعت الأرض ماءها وقيل للسماء: “اقلعي”!.
واكتملت كذلك بتخريب الكيان الاجتماعي بفعل ضغوط استمرت طيلة قرن كامل. لقد تخلى هذا الجسم الاجتماعي عن لبوسه التقليدي – أو أرغم على خلعه- ولم يستطع التلاؤم مع اللبوس الاستعماري الذي فصل على عجل. والمأساوي في الأمر هو عجز هذا المجتمع عن أي إبداع يمكن أن يؤدي إلى تجاوز “الموضة” القديمة، إقطاعية كانت أم استعمارية.
وهكذا تتكامل الحلقات المأساوية:
تتكامل بتراجع مستوى العقليات وتذبذب المواقف الاجتماعية. فأصبحت الوطنية عارا ينبغي إخفاؤه في مجتمع من تجار الضمائر.
وأصبحت الكفاءة والنزاهة المهنية نقيصتين تؤديان بالمتهم بهما إلى العقاب. وذلك لأن خفافيش الظلام تحاصر كل من يحاول إنفاذ الشرع في سراديب الفساد.
أما رجل الأعمال الناجح فإنه يكسب على الفور عصابة من “الأصدقاء الجدد” يتزلفون ويظهرون له أفانين من الحب والإخلاص. غير أنه يتعرض كذلك لحقد الجماعات الاشتراكية التي يدفعها الحسد والغيرة إلى اعتبار الربح وروح المبادرة مرادفين للاحتكار وغيره من ممارسات مجتمع الغابة.
إن هذا التحلل المعنوي العام قد وصل إلى حد التأثير على الرباط الأسري المقدس الذي يشكل الملاذ الأخير لحماية الكيان الاجتماعي المتداعي. وكثيرا ما ينحي باللائمة على المرأة بوصفها المسؤولة عن التفكك الأسري بفعل سلوكها الشائن. وكأن الرجال لم يكونوا البادئين والمشجعين للسلوك المنحرف بارتيادهم مظان الشبهات مع ما يظهرون في الحياة العامة من مواقف انتهازية وذيلية. إن الرجال مسؤولون عن ما وصلت إليه بلادنا من انحطاط أخلاقي ووصل إلى درجة أنه “لم يعد جبين المرء يندي لما كان بالأمس يؤدي للموت خجلا”.
إن تكدس (1/8) من سكاننا، بصورة غير لائقة ولا مفيدة، على شريط ضيق من رمال “تفلي” قرب الساحل الأطلسي، هذا التجمع وما صاحبه من هزات نفسية واجتماعية، قد يكون مصدر الضغط على مخيلة الشاعر ولا أستبعد أن يكون الضمير الجمعي لشعبنا –وهو ضمير تائه كما لاحظنا- قد وجه قلب الشاعر باتجاه البحث عن أسهل الحلول وهو…. الهريب.
ولنا بعد ذلك أن نتساءل عن السر في انتقاء الشاعر (احمدو) لشخصياته. ما الذي يمثل هؤلاء الرجال الذين لا هم لهم إلا قضم الأعلاف (ركل)؟ وما الذي يمثله العجائز اللواتي لا هم لهن إلا اجترار الأحلام بالحج إلى مكة واتقاء شر الشياطين باصطحاب (أحمر الشفاه)؟ ليس من غريب الآفاق أن لا يحمل “السفين” على ظهره إلا العجزة ومن على شاكلتهم ممن ليست له مساهمة جلية في تقدم المجتمع؟ ألا يعني هذا أن الشاعر قد اختار عن قصد (أو اختار له إلهامه) أن يخلص مجتمعنا من العجزة والطفيليين بتكديسهم على ظهر قارب يسير إلى “لا مآب” . وإذا الأمر كذلك، فإن من أغفل الشاعر ذكره من الأشخاص النشطين قد خلا لهم الجو يبنون وطنهم بجد واطمئنان… هذا إذا لم يكن الشاعر يرمز بالمسافرين العجزة إلى “الشعب الصبي” هذا المسخ الذي نتج عن سياسات النخبة الجديدة.
وبذلك يكون الشعب الذي فقد وعيه بفعل سياسات التجهيل والقمع، قد قطع مراسي “السفين” لينطلق بدون وعي في رحلة التيه والضياع الأبدي. هذا “الشعب الصبي” الذي فقد الثقة في النفس يسافر اليوم – “وهو يجهل أنه مسافر”- لأنه لم يعد سيد مصيره منذ أن أصبح الآخرون يفكرون نيابة عنه.
وبقي على الشاعر أن يحدثنا عن وجهة سفر “النخبة” أين ذهب هؤلاء الذين أوصلوا شعبنا إلى هذه الدرجة من اللاوعي؟
ربما يكونون قد غادروا البلاد بدورهم، لكننا لم نعرف على متن أي طائرة. … قد يكونون سافروا في مقاعد الدرجة الأولى من إحدى الطائرات النفاثة في اتجاه وجهة مريحة وآمنة!… من يدري؟…
ولكن، مهما تكن الظروف والأسباب، فإنه ينبغي أن نرفض بقوة هذا الحل الذي يقترحه الشاعر، لأنه في الحقيقة ليس حلا على الإطلاق… ليس هناك ما يمكن أن يعتبر سببا معقولا لهذه الهزيمة الوطنية.. ولا يوجد مسوغ لهذا الرحيل المؤذن بالفناء، على ظهر قارب ليس –في الحقيقة- إلا بحرا عائما تتقاذفه الأمواج ذات اليمين وذات اليسار.
وإنه لحري بنا أن نواجه ظروفنا بشجاعة وواقعية كما فعلت أجيالنا السالفة. وإذا كان الجفاف الذي نواجهه أوسع نطاقا مما سبقه لأنه ليس جفاف طبيعيا محضا، فلا ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى اليأس.
ولنا في أسلافنا أسوة حسنة، حيث واجه شعراؤنا الأقدمون كارثة الجفاف التي مست مناطقنا “ساحلها” وجبلها “آدرار” و”الترارزة”.. في كل هذه المناطق واجه الشعراء الجفاف، فما ضعفوا ولا استكانوا.
فقبل الاستعمار وما أدى إليه من هزات اجتماعية، وقبل ظهور الجفاف ونتائجه السلبية، كان الشاعر الحساني ينشد:
“كدية زُوغ أ زُوغ وتحداد القور والأسهاب ولمهاد ما فيهم حد تلاو أواد الجنة من الإسهاب ارتاح واللي كان ف حومة الأجواد عامر من الأسهاب والأسراح عاد اتبطو الارياح وعاد بو الأرياح اتبطو الأرياح
هذه الأبيات الزجلية التي مضى عليها أكثر من مائة عام، تصف جفافا حل بمنطقة “الساحل” منذ عهد بعيد. ومع ذلك فإنها تهز مشاعرنا بقوة كما لو كانت بنت يومها.
وهذا ما يظهر أن أجدادنا لم يقبلوا أبدا بأسلوب الاستقالة الجماعية في مواجهة الحياة. وإنه لحري بنا أن نتأثر بهم في صمودهم البطولي فنواجه الطبيعة ونرد على التحدي ولو كان عتيا.
وإذا كان الشاعر يقترح أن نزرع حزاما أخضر يغطي عرض البلاد من الحدود الساحلية إلى الحدود المالية، فإننا يمكن أن نتصور حدودا أخرى كثيرة.
فهناك مشروع “آفطوط الساحلي”، هذا الملف الذي أكل عليه الدهر وشرب. وهناك سهل “بوكه” الذي يمكن أن يتحول منظره من بقعة جرداء إلى بساتين رائعة يغطيها قصب السكر وتحيط بها مصانع التكرير.
ويمكن أن نتصور مراعي “الحوضين” وقد تحولت إلى حدائق لتربية الماشية، تغطيها مزروعات الفصة والذرة وغيرهما من النباتات العشبية وتتخلل حركة إنتاجية نشطة في معامل الدباغة.
وإلى الجنوب الغربي، تزدهر مزارع الفستق والدخن واللوبيا بالإضافة إلى أشجار الفواكه مما يمكن أن يعيد البهجة إلى مناطق “الديري” و”شمامة” و”قيدماغة” و”العصابة”.
أما في “آدرار” و”تكانت” فمن المهم إنقاذ حدائق النخيل وإدخال أشجار التين التي تنمو عادة حيث ينمو النخيل. وبذلك تزداد بهجة “الكيطنة” كما تزدهر مصانع التهيئة والتصبير.
إنه حلم جميل، وهو مع ذلك، ممكن التحقيق.. ممكن تماما أن ننشر أبراج الأسلاك الكهربائية في منطقة من سد “ماننتالي” لتنير المنطقة الشرقية من البلاد. وممكن تماما أن تصبح بلادنا في طليعة مصدري المناظر الساحرة عن طريق إنشاء قرى سياحية تنتشر في مختلف الولايات بحيث تظهر بلادنا للعالم مفاتن طبيعية تسحر السائحين الذي سيتقاطرون على شواطئنا الناصعة البياض وسيبحثون عن الكنوز النادرة في حوض “آركين” كما ستجلبهم مشاهد الواحات والمناظر الجبلية في “آدرار”.
وسيعجب الزوار وكذلك بمحاظرنا التي تكون قد جددت لتستعيد أمجادها السالفة وتجتذب آلاف الطلاب من موريتانيا ومن إفريقيا الغربية المسلمة، وسيتلقى هؤلاء الطلاب معارف أصلية ومسايرة للعصر، في نفس الوقت.
كل هذا جميل جدا، وأجمل من ذلك أنه قابل للتحقيق.
ولكن التنمية والتقدم والتناسق لا يمكن تحقيقها بمبادرات منعزلة، متناقضة في بعض الأحيان ومرتجلة في أغلبها.
فالنمو القطاعي والجهوي عنصر هام في دفع عجلة التقدم. إلا أنه يظل عنصرا جزئيا محدودة الفائدة، ما لم يندمج في تصور تنويري عام منطلق من منظور شمولي.
وعندما لا يندرج النمو في مخطط أشمل للتنمية الاقتصادية فعنه تنتج لا محالة نتائج عكسية، وقد عرفت بلادنا نماذج من هذا النمو الفوضوي، من أمثلتها النمو الحضري المتسارع في نواكشوط وحول مناجم الشمال، هذا النمو الذي شجع النزوح إلى المدينة بشكل أفرغ العالم الريفي من قواه المنتجة. وزاد في خطورة هذه الظاهرة مد طريق الأمل من “نواكشوط” على “النعمة” بدون القيام بالإجراءات الضرورية لتثبيت السكان في مناطقهم التي أصبحت وسيلة مغادرتها متوفرة لهم.
ليس من الغريب أن تتكدس هذه المجموعات البشرية الهائلة على الساحل الأطلسي مع كل ما يؤدي إليه ذلك من بؤس ومآسي اجتماعية.
ورأيي أن حل هذه المشكلة يكمن في قيام الدولة بدورها الحقيقي في الحلول محل الكيان الاجتماعي التقليدي المتفكك، وذلك من أجل القضاء على جو اليأس الجنوني الذي يؤدي إلى هذه المواقف الهروبية التي ترمز لها الهجرة و”سفينها”. إنه دور عظيم وصعب يجب على الدولة أن تلعبه.
ولكن، لنتفق أولا على تحديد مفهوم الدولة الوطنية، إنها –حسب رأينا- دولة التنسيق التي تضطلع بصلاحياتها كاملة ولكنها لا تتطلع إلى أي دور خارج عن صلاحيتها.
هذه الدولة تعتمد على إدارة تنموية وطنية لتنجز رسالتها المتمثلة في توفير الجو الملائم للمواطن الموريتاني كي يعيش مطمئنا في دولة محترمة. ومن أجل ذلك ينبغي أن تتجنب الزج ببلادنا في المواقف المتطرفة مثل الهجرة السندبادية التي يقترحها الشاعر.
فواجب موريتانيا أن تتبع نهجا متوازنا، وأن تكون نظرتها إلى الأمور متزنة هادئة تنطلق من اعتبارات لا مكان فيها للعواطف والأعصاب المتوترة. وعليها كذلك أن تنشد التوازن في صياغة النسيج الاجتماعي الجديد الذي ينبغي أن يتخذ شكل (الدولة القبيلة) بحيث يتم استقطاب الأشكال التقليدية في البنية المجتمعية الأصلية مع إتباع أساليب التدخل الدولي الحديث، كما تجب مراعاة التوازن في التعامل مع تراثنا الثقافي الذي ينبغي تطويره ليصبح عنصرا حيويا قادرا على المساهمة في حل المشكلات اليومية للمواطن العادي. إن روح التوازن ينبغي في الأخير أن تكون مصدر توجيه لسياسة تنموية منسجمة تستجيب لضغط لحاجات للمواطن البائس لكنها لا تنشغل عن التخطيط الهدف الاستراتيجي الأسمى وهو تحقيق مجتمع الرخاء في القرن العشرين.
إن إنجاز مثل هذه الأهداف يتطلب دولة وطنية بمعنى الكلمة:
– دولة لا تدعي القداسة وتقبل أن تنزل من عليائها لكي يستطيع المواطن العادي التعامل معها.
– إنها (الدولة –القبيلة) التي تحل محل الإطار التقليدي المهترئ.
وبذلك تتمتع بمزايا (العصبية) المتمثلة في ولاء المحكومين وثقتهم المطلقة وتماسكهم المتين.
– إنها (الدولة الأم) التي يلجأ إليها المواطن ليحصل على الدفء والحنان.
– وهي (الدولة المحايدة) التي تقف موقفا منصفا وعادلا بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. وبما أنها دولة الجميع فلن يكون لديها موقف مسبق ضد القطاع الخاص، بل ستعامله على قدم المساواة مع القطاع العام.
– وهي الدولة المتخلصة من أعباء تسيير المؤسسات المفلسة وغير ذلك من مظاهر الراسمالية الدولية. وبذلك تصبح حكما عادلا وعامل تلطيف للصراعات بين قطبي الحياة العامة (القطاع العمومي والقطاع الخصوصي).
– ثم إنها ستكون دولة اجماعية توزع المعونة على المحرومين وتجرد مجموعات الضغط الاقتصادية والسياسية (ما الفرق؟) من الأسلحة التي تمكنها من التأثير على مسار الحياة العامة.
– وأخيرا فإنها ستكون الدولة اللامركزية المشابهة للقبيلة الكبيرة في تقسيماتها الادارية، لأنها أي (الدولة) ستكون قد أصبحت قبيلة كبيرة، فالولاية هي (الفخذ) والتجمعات الحضرية هي (الأسر).
وبما أن الولايات والتجمعات الحضرية، في الدولة اللامركزية تمارس التسيير الذاتي بشكل مباشر، فإن ذلك سيوقظ روح المسؤولية والتنافس النزيه بين الإدارات التي ستصبح مدارس عملية لتكوين نخبة من المسيرين الأكفاء. ولن تواجه الإدارة، وهي أداة هذه الدولة أعباء كثيرة لأن تعميم التسيير الذاتي سيخفف عليها عبء ممارسة الوصاية العقيمة وغير النزيهة في بعض الأحيان.
وبهذا تتغير طبيعة الإدارة التي ستتحول من جهاز تسلطي يمارس القهر والتهديد إلى دورها الجديد بوصفها جهازا مرنا يطمئن المواطن ويحميه.
إن هذه الإدارة ستظهر الخصائص المميزة لمجتمع معين هو المجتمع الموريتاني في دولة محددة ج.ا.م ذات التراث الحضاري الإسلامي العربي الزنجي، وبكلمة واحدة ينبغي لهذه الإدارة أن يكون لها من التصور والإبداع ما يمكنها من أن تلعب بالنسبة لمواطنيها نفس الدور الذي كانت القبيلة تلعبه بالنسبة لمنتسبيها. وبذلك وحده تصبح أداة تعبوية على مستوى الآمال وفي حجم المخاطر.
– فلنحلم بتحقيق هذه الدولة المتطورة، هذه الدولة المعتمدة على الفطرة كأنها لبوس قد فصّل على مقاسات جسم الأمة، بحيث أصبحت هذه الأخيرة تتحرك فيه بصورة طبيعية ومريحة.
– ولنحلم بهؤلاء المواطنين المتخلصين من نزعة التسلط والرغبة في احتكار توجيه الحياة العامة ابتداء من الخطة السنوية وانتهاء بطريقة نقل القمامة.
– ولنحلم أيضا بهذا المواطن الذي يستعيد حقه في المسؤولية ويعي دوره كرافد للخزينة العمومية.
– لنتخيل هذا المواطن الذي أعيد تكوينه ليؤدي بهمة ونشاط، دوره الطبيعي بوصفه موجها للإدارة وخاضعا لها في نفس الوقت.
– ولنتصور هذه الدولة الجديدة وهذه الإدارة الرشيدة وما ستدفعان إليه من تغير للعقليات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.
ولن يعتبر المواطن أن الدولة وإدارتها مجرد أجهزة قمعية مفروضة من قبل المستعمر بل سيعاملها انطلاقا من مكانته كمساهم نشط ينتزع حقوقه ويؤدي واجباته التي قد تصل إلى حد التضحية بالغالي والنفيس من أجل المهمة التنموية النبيلة.
إن المواطن المتكيف مع البنى التقليدية، المستفيد من تغيير العقليات والمواقف الاجتماعية، سيصبح إنسانا جديدا إنسانا فرديا لكنه يعي متطلبات الحياة الاجتماعية، إنسانا منضبطا لأنه تنازل بكل طواعية عن جزء من حريته لصالح الجماعة. إنه إنسان راشد، يملك حق التفكير بحرية لتحديد خياراته الفلسفية والتعبير عن أفكاره، (إنه الإنسان المواطن) الذي يدفعه إحساسه الغامر بأهمية الأمن في المال والجسم، والحفاظ على الحرية في كافة مجالاتها، يدفعه كل هذا إلى الدفاع عن حوزة التراب الوطني ضد كل الأعداء، ولو أدى ذلك إلى التضحية العظمى.. الشهادة.
فهل يستطيع الجفاف (المادي) وغيره من أشكال الجفاف (المعنوي) الوقوف أمام هذه الإرادة الصلبة (إرادة الحياة والبقاء)؟
إن الانطلاق من منظور كهذا لا يترك أي معنى لهذه المقاطع الشعرية المتشائمة… وعلى العكس من ذلك تكتسب خاتمة القصيدة كامل دلالاتها التفاؤلية حيث يظهر أن الشاعر قد استعاد وعيه وعبر عنه. إنها صورة منعشة، صورة للطبيعة هي تستعيد نظارتها وتتزين لاستقبال المسافرين الذين أحرقوا سفينة العار وقرروا العودة.
وعلينا أن نتصرف قليلا في معادلة الشاعر. فنحول الشروط إلى متطلبات نعمل جميعا من أجل تحقيقها حتى نضمن البقاء لشعبنا على أديم أرضه متجذرا صامدا. وذلك هو قدرنا أن نناضل للحفاظ على أرضنا وعلى عالمنا كما نريده.
24/10/1984






