فقرة من: وجبة على النار…/ المرتضى محمد أشفاق
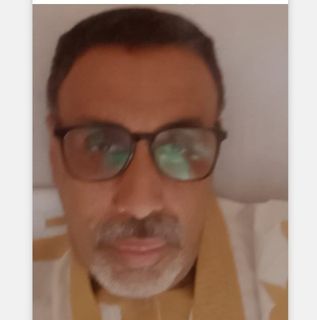
فكرت مرات قبل تقاعدي في الاستفادة من بعض تلاميذي المحليين من أبناء المدينة، والقرى التابعة لها، لإنشاء نواد أدبية وثقافية، نتبادل فيها التجارب، ونشجع فيها المبدعين والموهوبين، والهواة، ونعيد بذلك إلى مدينتنا بعض ألقها العلمي، والفكري، والثقافي المستقل..
لقناعتي أن الثقافة مرهم نتداوى به كلما اشتدت أوجاعنا السياسية، وفرقتنا الآراء والاتجاهات..
عندما استفدت من حقي في التقاعد مسحت من هاتفي أرقام المسؤولين الإداريين، والبلديين، والتربويين، وفي الإدارة المركزية لانتهاء موجب التواصل بيننا..رفضت أن تخدعني أخلاق بعض أولئك وأنا موظف، فأتصور غباء أنهم سيحتفظون بها وأنا خارج الوظيفة..
لم يرزقني الله طبيعة ديبلوماسية محابية، ومجاملة،
فأنا لا أهتدي في أروقة البنايات الإدارية في مدينتي، ولا أميز بين مكتب الحاكم ومكتب الوالي، ولا أعرف وظيفة بعض من رأيتهم مرة في بعض المكاتب يتسترون وراء الحواسيب..قادني خلاف مع أحد رؤساء المصالح في الولاية إلى الاستجابة لدعوة أحد الولاة لتسوية المشكل، ولما رآني كاتبه الخاص السيد(آو)، اندفع إلي مسلما وقال لي: مرحبا فلان، أنت نادر في مكاتب الولاية، صدق الأخ فما لي وللولاية، والولاة، والحكام، وبعضهم يرى نفسه أمة علوية مقدسة، ويرانا أمة سفلية مدنسة..وأنا لا أعاني من نقص في شخصيتي أكمله بعلاقة مع مسؤول مهما كانت رتبته، ولا أتشرف بصحبة من هم أعلى مني وظيفة…
لكنهم لن يروني وأقفا في الطابور أستمنحهم وثيقة لخنشات من القمح، أو للحصول على قطعة أرضية، أو لرئاسة مكتب تصويت..أو أي امتياز أنحني لاستلامه وضيعا، حقيرا..
بعد منتصف التسعينات رفضت المشاركة في مكاتب التصويت، حتى بعد أن صار تعويض رئيس المكتب خمسين ألف أوقية، ورفضت كلما ألح علي الأساتذة-المخدوعين بوعود عرقوبية من الإدارة وقد أدركوا الآن زيف تلك الوعود- بإرسال لائحتهم إلا الحاكم والوالي طلبا للقطع الأرضية، رفضت أن أسجل اسمي فيها، وعندما يستخبرني بعض إخوتي الأساتذة أرد عليهم أن عندي منزلا، ولست تاحر قطع أرضية، ولا أحب أن يُقرأ اسمي في ورقة تلف فيها بائعة صاندويس، أو(امبورو صوص) بضاعتهما، لأن مصير تلك الأوراق والرسائل سلة المهملات ليجمعها البوابون علفا لدواجنهم..
جل من سبقوني من المديرين حصلوا على قطع أرضية متعددة في مدينتي، واستفادوا من أثمانها، أما القطعة الأرضية التي أسكنها في مدينتي فقد اشتريتها، وليست منحة من حاكم، ولا وال، ولا عمدة..كيف أرضى أن أريق ماء وجهي، وأهدر كرامتي وكبريائي أمام هؤلاء ليذبحوني بمثل تلك الإكراميات، وأقبض ثمن مذلتي..
(لي عودة مفصلة إن شاء الله إلى هذا الموضوع عندما أتحدث عن علاقاتي بالإدارة المحلية)..
وجدت عندما كاد يجىء فكرتي المخاض أن شبابنا تقاسمته هجرتان، الهجرة التي استحقت أن تكون ظاهرة العصر:(ترصاف الحيط)، فبلوغ الحائط مرحلة مبشرة لأنها خاتمة لسلسلة من المغامرات، والمخاطر، مسرحها الغابات، والبحار، والمهربون المسلحون، والمطاردات التي تنتهي أحيانا بالموت..
وحسبك أن تعلم أن هذه المخاطر والمآسي وجدها المهاجرون خيرا لهم من البقاء في الفاقة، والبؤس، والغبن والتهميش..
أما الهجرة الثانية فسياسسة، هجرة شبابنا إلى السياسية، رغم الكفاءة، والأخلاق، لكن لا أحد يستطيع أن يأخذ على غيره ممارسة هوايته، وقناعته..
طبيعي أن يدرك تلاميذي الذين عرفتهم صغارا، في فترات أحلامهم الوردية الجميلة، وما ترسمه ريشات خيالهم من لوحات ذلك المستقبل الفاتن، أن لا شيء أحلى من سنوات الغفلة حين تختزل لك السعادة في لحظات شطح، وجموح، وتحصيل معرفي، ومطاردة لا تهدأ لأهواء النفس ومتعها..وما أقساها حين تنبهك، فتفتح عينيك عليك ترسف بين غابات الشيب ومتاريسه، وأخاديد التجاعيد وأنفاقها، لترى أن أحلامك الجميلة هي المطارد الذي لا يدرك، والمنتظر الذي لا يأتي..وتجد نفسك تتدحرج على عتبات الحياة الصلبة، وتبتلعك فجاجها الموحشة،،تكد، وتجد في طلب لقمة العيش، وتضيق بطلبات الصغار، وتكاليف دراستهم، ومعاشهم، تماما كما كان آباؤك يعانون من أجلك، وأنت عن شقائهم فيك من الغافلين..
اليوم تشعبت الحاجات، وكثرت المطالب، وبخلت الحياة، واستفحلت أوجاعنا الأخلاقية، والسياسية، والاجتماعية، واشتد الزحام على الموارد الشحيحة، فعلت قامات الأقزام، وجلجلت خطب الأميين، وتفاحش صعود التافهين، ولم يعد أمامنا من وسائل نخرج بها خلسة عن التدافع، والاختناق، والقحط الأخلاقي، والفكري، والمادي، وننسى بها حاضرنا المعتم إلا البحث عن الأطفال الصغار الذين كُنَّاهُم، وعن ذكريات عصرنا الذهبي المسلوب، نتحسس طعم أحلام حلوة ودعناها، وآمال حسان فقدناها، وننشد مع المجنون حنينا، وحسرة على ماض تولى، وزمان لن يعود:
تعلقت ليلى وهي غر صغيرة
ولم يبد للأقران من ثديها حجم
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا
إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم





