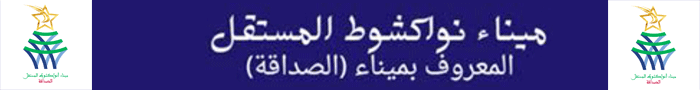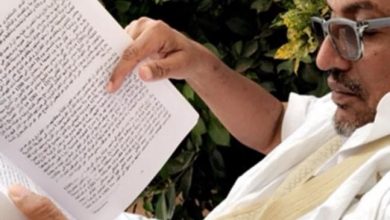آراءموضوعات رئيسية
بين سوء التسيير والاختلاس: حين يغدو الإهمال وجهًا آخر للفساد / محمد ولد لحظانه

في عالم الإدارة العامة، لا يحتاج الفساد دائمًا إلى نيةٍ مبيتة أو مخططٍ مسبق. أحيانًا يبدأ بخطأٍ في التقدير، أو بتهاونٍ في المراقبة، أو بارتجالٍ في القرار… ثم يتسع تدريجيًا حتى يصبح نزيفًا صامتًا في جسد المرفق العام.
وهنا، لا يعود السؤال عن “النية”، بل عن “النتيجة”: من دفع الثمن؟ ومن تحمّل كلفة الخلل؟.
سوء التسيير، في جوهره، ليس مجرد قصورٍ إداري، بل هو اختلالٌ في ميزان المسؤولية. فحين يُهدر المال العام بسبب غياب الكفاءة، أو غلبة المجاملة، أو ضعف الرقابة، لا يختلف الأثر كثيرًا عن أثر الاختلاس المباشر: مالٌ ضاع، وثقةٌ تآكلت، ومرفقٌ تعطّل.
الفرق بينهما، في نظر القانون، هو النية؛ أما في نظر المجتمع، فالنتيجة واحدة: تضييع الأمانة.
قد يبرّر البعض سوء التسيير بأنه “خطأ مهني” لا جريمة، وأن المسؤول ربما لم يكن فاسدًا بل “غير محظوظ” أو “مغبونًا بظروفه”. لكن الأمانة لا تُقاس بالحظ، ولا تُبرَّر بالظروف. فالمرفق العام ليس حقلَ تجارب، والإدارة ليست فضاءً للمحاولة والخطأ. ومن يتولى الشأن العام، يتولى معه مسؤولية دقيقة: أن يُحسن استخدام كل مورد، وأن يتصرف كما لو أن المال ماله، والوطن بيته، والوظيفة تكليفٌ لا تشريف.
في القانون، قد لا يرقى سوء التسيير دائمًا إلى مرتبة الاختلاس ما لم تتوافر النية والعمد، لكنه في ميزان الأخلاق والإدارة الرشيدة لا يقل خطرًا عنه. فهو يمهّد له الطريق، ويزرع في التربة ما ينبت عليه الفساد. فالإهمال المستمرّ بابٌ يُفتح على الغفلة، والغفلة تُفتح على التلاعب، والتلاعب يقود إلى الانحراف الصريح.
لقد أدركت الدول التي سبقت في مسار الإصلاح أن الفساد لا يُحارَب فقط بالقانون، بل بالمنظومة التي تمنع جذوره من التمدد. ولذلك، لم تنتظر وقوع الجريمة لتتحرك، بل وضعت أنظمةً للمساءلة الدورية، وربطت المسؤولية بالمردودية، ومنحت الكفاءة مكانها قبل الولاء. لأن حماية المال العام لا تبدأ من معاقبة الجريمة بعد وقوعها، بل من منع الخطأ قبل أن يتحول إلى فساد.
وقد بدا واضحًا أن النهج الحالي في البلاد قد استوعب هذه المعادلة جيدًا، إذ اتجه إلى تعزيز آليات الرقابة وتكريس ثقافة المساءلة، دون تسييس أو مجاملة. ولعل تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022–2023 يجسد هذا التوجه بوضوح، بما حمله من إشاراتٍ إلى الجدية في تتبع أوجه القصور وتصحيحها، في انسجامٍ مع روح القانون وأهدافه.
كما أن نشر التقرير وإتاحته للرأي العام، بوصفه إجراءً قانونيًا لازمًا، يعكس مستوى من الشفافية المؤسسية يؤكد أن مكافحة الفساد لم تعد شعارًا ظرفيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يمضي بثباتٍ وهدوءٍ ستكون له ما بعده من آثارٍ وإصلاحات.
أما ما رافق صدوره من مقاربةٍ إعلاميةٍ وُصفت من قبل بعض المتابعين بأنها أقل انسجامًا مع طبيعة المؤسسة وأدواتها القانونية، فيبدو أن الغرض منها – في جوهرها – كان التوضيح والتذكير بالمسار، لا استبعاد المساءلة التي تبقى ركنًا أصيلًا في النهج القائم. وهي، في النهاية، تفصيلٌ لا يقلل من قيمة المسار نفسه، بقدر ما يذكّر بأن الإصلاح لا يُقاس بما يُقال عنه، بل بما يُبنى في صمتٍ واتساقٍ مع القانون.
محمد ولد لحظانه.
وهنا، لا يعود السؤال عن “النية”، بل عن “النتيجة”: من دفع الثمن؟ ومن تحمّل كلفة الخلل؟.
سوء التسيير، في جوهره، ليس مجرد قصورٍ إداري، بل هو اختلالٌ في ميزان المسؤولية. فحين يُهدر المال العام بسبب غياب الكفاءة، أو غلبة المجاملة، أو ضعف الرقابة، لا يختلف الأثر كثيرًا عن أثر الاختلاس المباشر: مالٌ ضاع، وثقةٌ تآكلت، ومرفقٌ تعطّل.
الفرق بينهما، في نظر القانون، هو النية؛ أما في نظر المجتمع، فالنتيجة واحدة: تضييع الأمانة.
قد يبرّر البعض سوء التسيير بأنه “خطأ مهني” لا جريمة، وأن المسؤول ربما لم يكن فاسدًا بل “غير محظوظ” أو “مغبونًا بظروفه”. لكن الأمانة لا تُقاس بالحظ، ولا تُبرَّر بالظروف. فالمرفق العام ليس حقلَ تجارب، والإدارة ليست فضاءً للمحاولة والخطأ. ومن يتولى الشأن العام، يتولى معه مسؤولية دقيقة: أن يُحسن استخدام كل مورد، وأن يتصرف كما لو أن المال ماله، والوطن بيته، والوظيفة تكليفٌ لا تشريف.
في القانون، قد لا يرقى سوء التسيير دائمًا إلى مرتبة الاختلاس ما لم تتوافر النية والعمد، لكنه في ميزان الأخلاق والإدارة الرشيدة لا يقل خطرًا عنه. فهو يمهّد له الطريق، ويزرع في التربة ما ينبت عليه الفساد. فالإهمال المستمرّ بابٌ يُفتح على الغفلة، والغفلة تُفتح على التلاعب، والتلاعب يقود إلى الانحراف الصريح.
لقد أدركت الدول التي سبقت في مسار الإصلاح أن الفساد لا يُحارَب فقط بالقانون، بل بالمنظومة التي تمنع جذوره من التمدد. ولذلك، لم تنتظر وقوع الجريمة لتتحرك، بل وضعت أنظمةً للمساءلة الدورية، وربطت المسؤولية بالمردودية، ومنحت الكفاءة مكانها قبل الولاء. لأن حماية المال العام لا تبدأ من معاقبة الجريمة بعد وقوعها، بل من منع الخطأ قبل أن يتحول إلى فساد.
وقد بدا واضحًا أن النهج الحالي في البلاد قد استوعب هذه المعادلة جيدًا، إذ اتجه إلى تعزيز آليات الرقابة وتكريس ثقافة المساءلة، دون تسييس أو مجاملة. ولعل تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022–2023 يجسد هذا التوجه بوضوح، بما حمله من إشاراتٍ إلى الجدية في تتبع أوجه القصور وتصحيحها، في انسجامٍ مع روح القانون وأهدافه.
كما أن نشر التقرير وإتاحته للرأي العام، بوصفه إجراءً قانونيًا لازمًا، يعكس مستوى من الشفافية المؤسسية يؤكد أن مكافحة الفساد لم تعد شعارًا ظرفيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يمضي بثباتٍ وهدوءٍ ستكون له ما بعده من آثارٍ وإصلاحات.
أما ما رافق صدوره من مقاربةٍ إعلاميةٍ وُصفت من قبل بعض المتابعين بأنها أقل انسجامًا مع طبيعة المؤسسة وأدواتها القانونية، فيبدو أن الغرض منها – في جوهرها – كان التوضيح والتذكير بالمسار، لا استبعاد المساءلة التي تبقى ركنًا أصيلًا في النهج القائم. وهي، في النهاية، تفصيلٌ لا يقلل من قيمة المسار نفسه، بقدر ما يذكّر بأن الإصلاح لا يُقاس بما يُقال عنه، بل بما يُبنى في صمتٍ واتساقٍ مع القانون.
محمد ولد لحظانه.