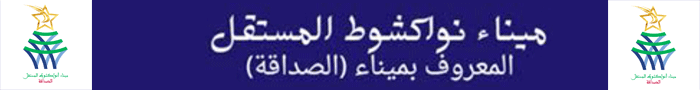بين الوعي الغائب والاغتراب السلوكي تحليل سوسيولوجي في ازدواجية المواطن / قاسم صالح

الهدف من هذه القراءة ، هو فهم، وتفسير العوامل المتحكم في السلوكي لدى المواطن الموريتانية بين الداخل والخارج، أي بين سلوكياته في الوطن الأم والتزامه في المجتمعات الغربية، وتقارب هذه الظاهرة من منظورٍ بنيوي ثقافي، يربط بين غياب الثقة بالدولة، وضعف التربية المدنية، واستبطان الخضوع بدل المشاركة.
تعتمد الورقة مقاربة تحليلية تستند إلى مفاهيم من ابن خلدون في العصبية، وإرفنغ غوفمان في تمثلات الذات، ومحمد عابد الجابري في نقد العقل العربي.
من الملاحظ أن المواطن الموريتاني الذي يتجاهل النظام في وطنه، ويتعامل مع القانون بوصفه أداة قهر لا أداة تنظيم، يتحول في البلاد الأوروبية إلى نموذجٍ في الانضباط، لا يرمي النفايات في الشارع، يلتزم بإشارات المرور، يبلغ الشرطة عند أي خرق للنظام، يقف في الطابور بصبرٍ، ويصوت بناء على الكفاءة لا على العصبية.
هذه الازدواجية السلوكية لا يمكن فهمها فقط كاختلاف في البيئة، بل كنتاجٍ لتاريخ طويل من الاغتراب بين الفرد والدولة في موريتانيا، حيث فقدت الثقة المتبادلة، وتحولت المواطنة إلى علاقة قهرية لا تعاقدية.
يرى محمد عابد الجابري أن أحد جذور الأزمة في المجتمع هو (غياب البنية العقلانية في الوعي الجمعي)، أي هيمنة العقل التبريري على العقل النقدي. وهذا التبرير المستمر للسلطة – أو ضدها – جعل المواطن يعيش ازدواجا داخليا بين ما يفكر به وما يمارسه.
أما ابن خلدون فقد وصف مثل هذا الانقسام بعباراته عن (فساد العمران حين تستعبد العصبية العدل)، أي حين يتحول الولاء من المبدأ إلى القرابة، ومن القانون إلى المصلحة. فالمواطن الذي يطيع القانون في أوروبا ليس بالضرورة (تحضرا)، بل لأنه يجد نفسه في بيئة يسود فيها عدل لا عصبية. وحين ينتقل إلى وطنه تحكمه العصبيات، يعود إلى منطق (التحايل) و(الواسطة)، لأنه يرى أن العدالة انتقائية.
تؤكد المقاربات السوسيولوجية الحديثة (مثل ما يطرحه بيار بورديو) أن السلوك الفردي لا ينفصل عن (الهابيتوس) أو البنية الداخلية التي يصنعها المجتمع، فحين يعيش الإنسان في بيئة لا تحترم القانون، ولا تقدر المصلحة العامة، يصبح التحايل مهارة اجتماعية، والالتزام ضربا من السذاجة.
وهذا ما نراه في موريتانيا، المدرسة لا تربي على المواطنة، الأسرة تعلم أبناءها (كيف يتجنبون الشرطي لا كيف يحترمونه)، والإعلام يقدم الفساد باعتباره واقعا لا يمكن تغييره، بهذا المعنى، ليست الفوضى صدفة، بل نتيجة لبنية تكرس اللاانتماء.
يقدم عالم الاجتماع الأمريكي إرفنغ غوفمان حلا مهما لهذه الازدواجية عبر مفهومه (عرض الذات في الحياة اليومية)، فالفرد – في نظره – يمثل أدوارا مختلفة بحسب المسرح الاجتماعي الذي يوجد فيه.
حين يعيش المواطن الموريتاني في الغرب، فهو على المسرح، تحت أنظار سلطة صارمة ومجتمعٍ يراقب السلوك المدني، فيضطر إلى تمثيل دور (المواطن المثالي).
أما في وطنه، فالمسرح بلا جمهور ولا مساءلة، فيرتدي قناع (المتحايل) أو (اللامبالي)، لأن النظام نفسه لا يمنحه دورا ذا معنى.
إن أزمة السلوك ليست أخلاقية بقدر ما هي سياسية معرفية. فالمواطن لا يخرق القانون لأنه شرير بالفطرة، بل لأنه فقد الإحساس بالانتماء، في غياب العدالة، يتحول القانون إلى سلطة، والنظام إلى قيد، والحرية إلى فوضى.
إن بناء المواطنة يبدأ من الثقة في الدولة العادلة، لا من الخوف من الشرطي، فحين تكون الدولة نموذجا في احترام القانون، سيصبح احترام المواطن له فعلا طوعيا نابعا من الضمير الجمعي.
إن الحل لا يكمن في (تربية الأفراد) فقط، بل في إصلاح البنية السياسية والثقافية التي تنتج السلوك، فالمواطنة لا تزرع بالشعارات بل بالممارسة، والقانون لا يكتسب قداسة إلا حين يكون الجميع أمامه سواء.
والمدرسة والإعلام والمؤسسة الدينية يجب أن تستعيد دورها في بناء (الضمير الجمعي) لا(الطاعة العمياء).
حينئذ، لن نحتاج إلى شرطي يراقبنا في المرور، ولن نبحث عن (جنسية بديلة) كي نمارس إنسانيتنا، لأن الوطن سيكون فضاء للكرامة لا ساحة للنجاة الفردية.
التحضر ليس سلوكا مستوردا، بل انعكاس لعلاقة الإنسان بذاته وبوطنه. إن ازدواجية المواطن الموريتاني بين الداخل والخارج ليست إلا مرآة لغياب العدالة وشعورٍ عميق باللاجدوى. وحين نستعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم، بين القانون والضمير، سنستعيد الإنسان الذي لا ينتظر أوروبا ليكون مهذبا، بل يكفيه أن يكون موريتانيا حقيقيا في وطن يحترم ذاته.
قاسم صالح.