الديموقراطية الليبرالية ومأزق النموذج التمثيلي
تواجه الديموقراطية الليبرالية في نموذجها الأبرز (التمثيلي) ضغوطا كثيفة لم تواجهها منذ صاغ معالمها الأساسية الفيلسوف الإنكليزي جون لوك، منتصراً لثورة البرلمان على العرش الملكي والنبلاء الإقطاعيين، مؤكداً على حق التمثيل النيابي لجموع الشعب، وحق البرلمان في التشريع لجموع المواطنين. لقد مرت قرون ثلاثة وأربعة عشر عاماً على رحيل جون لوك (1632- 1704)، تدفقت خلالها أربع موجات أساسية من الديموقراطية تجسد أولها في الثورتين الديموقراطيتين اللتين أسستا للنظام الجمهوري وهما: الأميركية (1776) والفرنسية (1789)، وتمثلت الأخيرة في هجرة النظم السلطوية العالم ثالثية والأخرى الاشتراكية في شرق أوروبا إلى الديموقراطية الغربية في أعقاب نهاية الحرب الباردة وانهيار حائط برلين (1989) ثم انهيار الاتحاد السوفياتي نفسه (1991)، وهي أوسع موجات الديموقراطية انتشاراً وأكثرها عمقاً، لأن تدفقها صاحب انهيار الأيديولوجية الأساسية المنافسة لها على حكم العالم طيلة قرن على الأقل، لعله الأهم في التاريخ الإنساني، ومن ثم ارتبطت بمقولات تبشيرية من قبيل الانتصار التاريخي أو التحول المفصلي، والتي بلغت ذروتها في مقولة نهاية التاريخ الأكثر دعائية.
اليوم، بعد ربع قرن بالتمام من تلك الموجة الانفجارية، بلغت الديموقراطية حداً من الإنهاك صار مثيراً للتفكير في مستقبلها، إذ لم تعد تلك الأيقونة التي ينظر إليها باعتبارها نهاية التاريخ، بل صارت تواجه أزمات في كل مكان تقريباً، وتتعرض لموجات شعبوية ونزعات فوضوية حتى في قلب جغرافيتها التقليدية: أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية. ففي أوروبا تقف الأحزاب التقليدية سواء كانت يمينية أو اشتراكية ديموقراطية، والتي كانت تناوبت على الحكم طيلة العقود السبعة الماضية، عاجزة أمام خطر ذوبان وتبخر قواعدها الشعبية، وهي ظاهرة صاحبت التحول الفلسفي من فكر الحداثة إلى ما بعد الحداثة من ناحية، والتحول السوسيولوجي من المجتمع الصناعي إلى ما بعد الصناعي من ناحية ثانية، حيث أفضت الثورة التكنولوجية منذ عقد الثمانينات، والتي تسارع إيقاعها في مطالع القرن الحالي، خصوصاً مع بروز دور وسائط التواصل الاجتماعي، إلى تحولات في وسائل إنتاج المعلومات وتداولها على نحو يفضي إلى مزيد من ديموقراطية حركيتها، ولكنه يقلل من مصداقيتها، كونه يضعف آليات الرقابة عليها. فالكل صار منتجاً ومستهلكاً لها في الوقت نفسه.
في هذا السياق يمكن فهم الموجة اليمينية والنزعات المحافظة، التي سادت القارة الأوروبية أخيراً انطلاقاً من بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، إلى فرنسا التي تبدي ميلاً متزايداً نحو اليمين السياسي سواء التقليدي أو القومي العنصري إلى درجة الخوف من مجيء الأخير إلى الحكم، الأمر الذي أتى بالرئيس ماكرون إلى سدة الرئاسة بقوة الخوف من وقوعه أكثر منه بقوة الأيديولوجية الراسخة أو الأحزاب التقليدية، بل عبر التمرد عليهما، والتصرف خارج ما يعرف بـ «المؤسسة». ثم إلى إيطاليا رفضاً لتعظيم دور الدولة الاقتصادي، ولسياسة الحكومة الاشتراكية هناك، وتبقى ألمانيا معرضة لمخاطر: صحيح أنها لم تقتلع السيدة ميركل من موقعها ولكنها ضيقت الخناق عليها بما قد يفضي إلى تغييرات كبيرة في سياساتها الأكثر ليبرالية وخصوصاً ما يتعلق باستقبال اللاجئين والتسامح مع التنوع الثقافي، وبعض من دور الدولة في الاقتصاد، وقدر من العدالة الاجتماعية.
يظل اعتقادنا الشخصي هو سلامة القيم الجوهرية التي تنهض عليها الديموقراطية، فما تمثله من غايات تحررية، وما تصبو إليه من رشد القرار السياسي، أو تسعى إليه من إدارة سلمية للتنوع الديني والقومي، إنما يبقى أهدافاً مشروعة: عقلانية وإنسانية. لكن، في المقابل، فإن جماع التحولات التاريخية المحيطة بها إنما تفضي إلى تغير في الطرائق التي تمارس من خلالها، وأعني في ذلك الشكل التمثيلي القائم على اختيار نواب عن الشعب، من خلال سباق حزبي، بما قد يفضي إلى أنواع جديدة من المشاركة المباشرة التي صارت تتيحها التكنولوجيا في هذا العصر على نحو لم يكن قائماً في الماضي القريب.



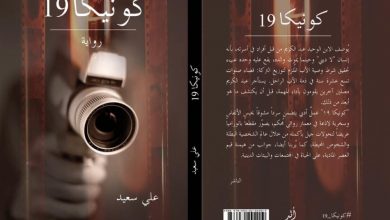

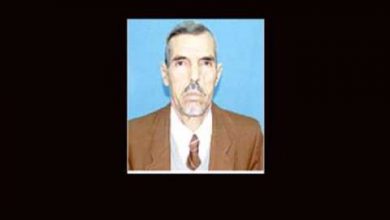

29 تعليقات