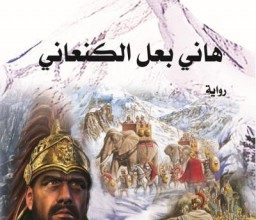يوتوبيا الحتمية التاريخية في مواجهة الروحانية الدينية

كان توماس هوبز، منذ القرن السادس عشر، قد خط طريق النقد النظري للدين عندما تخيل الله وقد نأى بنفسه عن العالم، تاركاً الناس لمصائرهم الواقعية من دون عناية بهم، أو رغبة في خلاصهم أو حتى قدرة على تخليصهم، وهو الخيال الذي أسس لفلسفة الدين الوضعية. أما العالم الفيزيائي جوردانو برونو فقدم فلسفته عن الله باعتباره «المبدأ والعلة»، مرسخاً لمذهب الدين الطبيعي، القائل بأن الله لم يخلق الطبيعة فقط، ولكنه أيضاً يتجلى فيها، ومن ثم ينعكس في الأعراض والمظاهر التي تحيط بميدان التجربة الواقعية. وهو فهم قريب إلى ما يذهب إليه سبينوزا الذي تصور الله- جل شأنه- وقد ذاب في العالم الطبيعي، ملتبساً بصورة قوانينه المادية، ليصبح هو العلة الباطنة للأشياء جميعاً، ولكن غير المتعدية أو المستقلة عن العالم الطبيعي وقوانينه.
وأما تنويريو القرن الثامن عشر، خصوصاً في الطبعة الفرنسية اليعقوبية، فوضعوا العقل في موقع المطلق، على صعيد فهم العالم المحيط بنا، كما جعلوا من الخبرة الإنسانية وحدها، ومن القيم الوضعية النسبية المتغيرة مطلقاً جديداً يقاس به وإليه صوابية اتجاه السير البشري، وتتحدد في ضوئه غايات الاجتماع الإنساني، استقلالاً عن المرجعية الإلهية إن لم يكن في ضديتها. وقد أعاد فولتير بالذات إحياء المفهوم الأرسطي عن الله كـ «محرك أول» للعالم، قام بخلقه ووضع فيه قوانين حركته، ولكنه استقل عنه وفقد اهتمامه بمصيره، فلم يعد يرعى حركة الكواكب أو مسيرة الإنسان، ولم يأمر بأي نظام أخلاقي يتسامى على الخبرة الواقعية. رسم أرسطو معالم تلك الصورة في ذروة العقلانية اليونانية قبل أكثر من ألفي وثلاثمائة عام، وها هو فولتير يستعيدها في لحظة الذروة التنويرية قبل أكثر من مئتي عام، معتبراً أن الله قد ضمن عنايته فقط في قوانين الطبيعة التي استنها، فيما نزعها عن مسيرة التاريخ البشرى، التي لم تعد تتحرك نحو نقطة نهاية معروفة أو غاية مقصودة كما يتصور أصحاب الدين التقليدي/ المسيحي. مثلما نزعها عن مصير الإنسان الفردي، فطالما أن الناس لا يستطيعون التعرف على أية أوامر خاصة «أخلاقية» كي يطيعوها التزاماً بالمشيئة الإلهية، فإنهم في المقابل لن يتمتعوا بالعناية الإلهية باعتبارهم أفراداً، يدعم الله جهودهم أو يبارك لهم في أرزاقهم، أو يمنحهم أقداراً سعيدة أو حتى يخفف عنهم أقدارهم المؤلمة.. وهكذا توارت القواعد الأخلاقية وراء المبادئ الكلية للعقل البشري، واختفت العناية الإلهية بالمؤمنين خلف القوانين العامة للطبيعة، على نحو قلص الشعور باليقين وأوجد نزعات شكوكية عميقة في السردية التاريخية الكبرى عن الله والدين.
وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان ثمة نزعة مثالية في التنوير الألماني تتجذر في الموروث الكانطي، خصوصاً لدى شليجل وفيخته وهيجل، حيث الأخير بالذات لم يطلق مقولات معادية صراحة للإيمان المسيحي، وإن وضع الدين في مرتبة وسطى بين الفلسفة والدين على طريق الفهم الإنساني للحقيقة. ولكنه، في المقابل، منح الفكر الألماني خصوصاً والغربي بل الإنساني عموماً، مفهوماً جديداً أثيراً سوف يغير تلقائياً وتدريجياً طريقة فهم الأشياء كلها.. إنه بالقطع مفهوم الجدل الهيجيلي «الديالكتيك» القائم أساساً على مبدأ التناقض والثالث الموضوع، حيث يدور الصراع بين الثنائيات الفكرية المتضادة، بحثاً عن الموقف الثالث/ المركب الجديد الذي سرعان ما يتحول في حركة الواقع، وانطلاقاً من آلية الصراع الدائم، إلى طرف في ثنائية جديدة يصارع طرفها الآخر. وهكذا تمكّن هيجل من نسف المنطق الأرسطي القائم على مبدأ عدم التناقض، والثالث المرفوع وما صاحبه من نزعة سكونية اعتاش عليها واستند إليها الفكر الإنساني لأكثر من الألفي عام، مطعماً بقدر كبير من اليقين. وفي المقابل بذر الفيلسوف المثالى! نزعة شكية عميقة، سرعان ما نمت لتصبح عامل إرهاق للذهن الحديث، وعامل تحفيز لإنتاج النزعات المادية.
أما مفكروا النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تأثراً بالداروينية، والنزعة التطورية الشاملة المصاحبة لها، فأخذوا يتحدثون عن تقدم حتمي وشامل للتاريخ الإنساني إلى الأمام، وعلى كل الأصعدة على نحو يدفعه إلى السير في خط مستقيم، يتوازى مع نضوج العقل الإنساني، ويتساوق مع نمو العقلانية الحديثة. ما يعنى حلول منطق العقل الجديد بديلاً كاملاً عن منطق الروح القديم، الذي يقع الدين في قلبه، ومن ثم يموت الدين، باعتباره معرفة عصر بدائي غارب، تحت أقدام الحتمية التاريخية، حسبما ذهب ماركس ونيشة وفيورباخ وفرويد وكونت، كتطبيق أمين لفلسفة الدين الوضعية.
ولم تُقصر إيديولوجيا التقدّم ادعاءاتها على القول بنهاية الدين بل ذهبت إلى اعتبار نفسها البديل القادر على الحلول محله في حفز حركة التاريخ، تعويلاً على طاقة الإنسان اللامحدودة، وتطلعه الدائم إلى المستقبل. وبدلاً من الغائية التقليدية التي ترى أن التاريخ يسير بتوجيه إلهي، ما يعنى أن الفناء ثم البعث في عالم آخر، هو مآل التاريخ البشري، وأنه مستمر ما دامت المشيئة الإلهية تقضي بذلك، طُرحت غائية جديدة جوهرها أن التاريخ يتحرك حسب إرادة الإنسان، وإن إمكانية إنهائه تبقى في حدود طاقته. وهكذا أفضى السعي إلى الخلاص من المركزية الإلهية إلى المبالغة في ترسيم معالم المركزية الإنسانية.
تفسير ذلك أن الإنسان يظل دوماً بحاجة إلى مرجعيات كبرى يمكن القياس إليها والاستناد عليها، كي يتمكن من حفظ توازنه، وإلا داهمته الشكوك. وقد لعبت الطبيعة بأجرامها الكبيرة دور تلك المرجعية لمرحلة طويلة في التاريخ «الأسطورية»، قبل أن ينتقل هذا الدور إلى الله/ الدين، الذي لعبه بإتقان مفهوم ومبرر. أما وقد نمت الرغبة في التنكر لله، فكان مطلوباً أن ترث دوره مرجعية أخرى، تضمن استمرار النظام في الطبيعة والتاريخ. ومن ثم تم رفع العقل باعتباره ملكة الفهم، مع مخرجاته من قبيل العلم/ التقدم/ الحداثة، إلى مرتبة المطلق، ورفع الايديولوجيا إلى مرتبة الدين، لتحل الماركسية، عقيدة أرضية، محل المسيحية كديانة سماوية، وأيضاً التنكر لأنبياء الوحي في مقابل التمحك بأنبياء السياسية، ورفض المخلص الديني/ المسيح الفادي طلباً للمخلص العلماني/ العامل البروليتاري، حيث الطبقة العاملة وحدها قادرة على تخليص الوجود البشرى من جل مظاهر الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي، الناجمة عن غياب المساواة بين البشر. وهنا كان ضرورياً أن يستحيل معتنقي الشيوعية إلى شعب الله المختار، المستحق للخلاص من دون الرأسماليين «الكفرة» الذين لم يبذلوا في فهم وإدراك حركة التاريخ، أي المادية الجدلية، ذلك القدر الذي يؤهلهم للنجاة من المصير الرأسمالي البغيض! وهكذا استحالت رؤية ماركس للتاريخ أشبه برؤية لاهوتية جديدة مركزها إنساني، ومحيطها إيديولوجي، وقلبها سياسي، وجوهرها مادي. أخذت تنزع كل ممكنات الحرية لدى الإنسان كي تمنحه حياة منظمة خالية من الألم. غير أن المفارقة الكبرى أنها زادت من ألمه، بنفس القدر الذي خصمت به من حريته، فكان سقوطها المدوي بعدما برز خداعها الكلى.
وبعد نحو القرن من الإلحاد السوفياتي أخذ الإيمان المسيحي الأرثوذكسي يستعيد حيويته في روسيا ومعظم دول أوروبا الشرقية. وهكذا فشلت إيديولوجيا التقدم كذراع للحتمية التاريخية في لعب دور البديل «الإنساني» للدين، لأنها كي تنجح في ذلك كان عليها أن تتحول هي نفسها إلى دين جديد «وضعي» له آلهته وأنبيائه وطقوسه، ربما الأكثر وطأة في الضغط على المصير الإنساني.
لا نقلل هنا من أهمية مفهوم التقدم أو ضرورته لصوغ رؤية إيجابية للتاريخ، تنظم عمل الإنسان وتحفز محاولات تغيير العالم المادي إلى الأفضل، ولكننا فقط نرفض تحويله إلى عقيدة كاملة، لأنه وحده لا يكفي لصوغ رؤية شاملة للوجود، قادرة على حفز جميع الملكات الإنسانية: الأخلاقية والروحية، وليس فقط المعرفية والسياسية، أو على منح الحضور الإنساني معنى كلياً ومتسامياً، يجعله أكثر سيطرة على نزعات الشر والعبث الدفينة فيه. فالمزيد من التقدم المادي، والنمو التكنولوجي (وهما معاً صلب عملية التقدم) لا يقوضان الحاجة إلى الدين، بقدر ما يزيدان منها، حيث التنامي المفرط للقوة المادية يفرض الحاجة المتزايدة للقيم الروحية الأكثر جوهرية، كي يبقى ضمير الإنسان في مستوى حذق عقله وقوة عضلاته.
صلاح سالم – الحياة