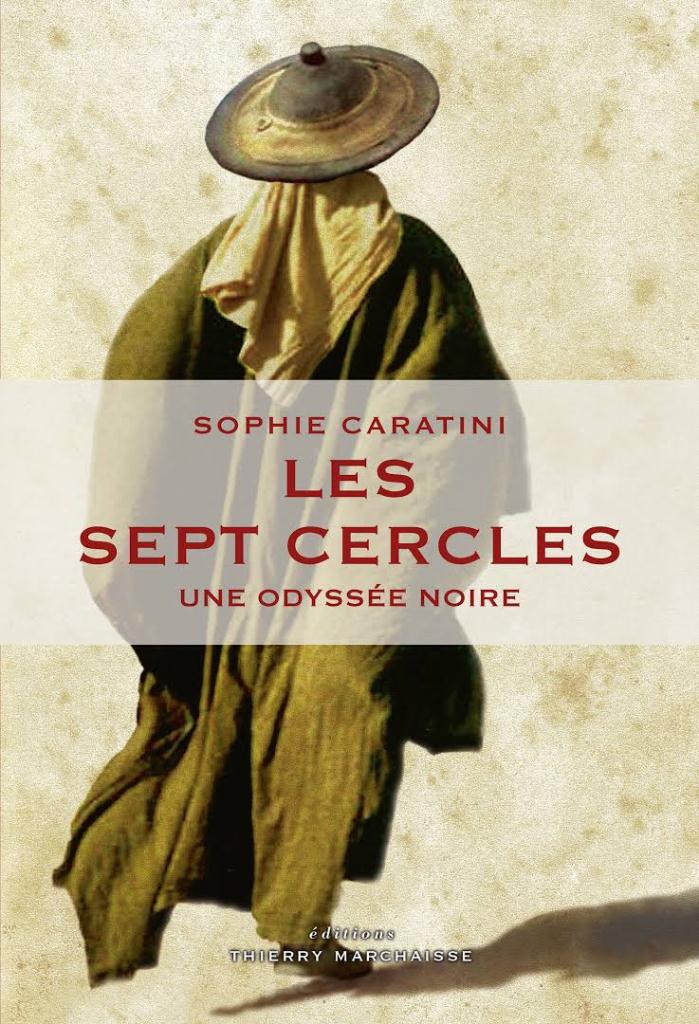كتاب عربموضوعات رئيسية
الجزائر: تاريخ أهمله التأريخم/ دكتور محيي الدين عميمور

عودة بالذاكرة إلى عهد مضى … عهد غسلته سيول نوفمبر (الثورة)… عودة مقرونة بالتفكير المحايد … بدون خطابة … بدون تحيز.
كانت الصورة التي تمثلها العروبة في ليل الاستعمار … هي صورة القدسية والاستشهاد … العربية هي لغة القرآن … لغة أهل الجنة … ضوء روحاني ينير القلوب … تتعطش إليه أفئدة المؤمنين … مارسوا أم لم يمارسوا شعائر الدين، اقترنت بالكفاح المسلح كما اقترن به هتاف … الله أكبر.
مقابل هذا كله .. كانت الفرنسية تمثل العلم والحضارة والتقدم، وإذا كانت العربية تعتمد – هكذا أريد لها مفهوما – على الملائكة كقوة ضاربة، وعلى شيكات في بنك الجنة، فالفرنسية هي قوة ذاتية لأنها – هكذا أريد لها أن تفهم – لغة البارود .. لغة الصاروخ .. لغة البينيسيلين والبي 12.. هي لغة الإدارة ولغة التعامل .. باختصار .. هي لغة العصر.
هكذا – رغم كره الاستعمار – كانت الفرنسية.
وهكذا ظل مفهوم العربية عند الجماهير.
وابن الصحراء يحب جمله .. ولكنه ينحني احتراما أمام النفاثة.
أمام القوى التي لا يفهمها .. والتي لا يستطيع امتلاكها.
وهطلت أمطار نوفمبر فغسلت عن وجه الجزائر أدخنة قرن وربع .. وجاء ربيع مارس (إيقاف إطلاق النار) .. ثم سطعت شمس يوليو (إعلان استعادة الاستقلال).
فهل جفت الأوحال ؟ هل عاد للجزائر وجهها الحقيقي بعد الاستقلال ؟ هل تغيرت النظرة ؟ تصفعنا الإجابة .. ذلك أن “ثلاث سنوات” كانت أقسى على التعريب من قرن وربع.
هنا كان العدو بين الصفوف .. لعله كان يتقدم بعض الصفوف .. ارتدى ثوب الصديق .. ثوب الأخ .. ثوب الشقيق.
والأصدقاء .. كانوا أقسى علينا منه .. عبثوا بجراحنا .. فتقيحت وتحول الدم فيها إلى صديد.
كيف كان الموقف غداة الاستقلال ؟
مزيج من الفرحة الطاغية والدهشة .. ضحكات على الفم ونظرة إلى المجهول .. وسريعا أمرّ عبر هذه الفترة التي مازالت ذكراها حية في النفوس .. أمرّ .. ثم أتوقف .. ومن بعيد .. التفت خلفي لأحاول رسم الملامح العامة كما أراها من هنا .. من ربوة مطلة على وادي الذكريات.
وعلى البعد، وفي وسط الجماهير المتطلعة إلى مستقبل أسعد .. الجماهير التي كان الاستقلال بالنسبة لها نهاية المطاف .. لحظة الإفطار بعد يوم قائظ الحر من أيام رمضان .. على البعد تبدو كتل أميبية .. متناثرة حائرة .. قلقة .. تتجمع وتتسلل بهدوء وبدون لفت للأنظار.
ورددت الجبال صوت التاريخ .. عادت الجزائر إلى حظيرتها الأصلية وإلى مجالها الحيوي، وإلى مكانها الطبيعي بين شعوب الأمة العربية .. والجماهير تزغرد .. فرحة الابن المغترب عند أمل لقاء الأهل والأحباب.
ودق ناقوس الخطر .. ينبه الذين كان الاستقلال بالنسبة لهم نقطة وثوب إلى آفاق جديدة .. النفوس التي تغلى بالتطلعات الطبقية الطامحة إلى ملء الفراغ القيادي والإداري الناشئ عن زوال القوة الاستعمارية.
هم الصغار الذين عاشوا على هامش الإدارة الحكومية قبل الاستقلال .. حملة ملفات أو فيران مكاتب .. ثقافتهم محدودة وإدراكهم الوطني .. محدود .. ولكن الوطن الأم !! منحهم فرصة الاحتكاك بالجهاز الإداري فكانت لهم بذلك بعض خبرة .. وهم بذلك يؤمنون بصاحب الفضل .. فلولاه لظلوا أصفارا .. كانوا كخادمة ريفية عاشت عند أسرة أوروبية .. تعود إلى أهلها في الدوار لكي ” تفوخ ” عليهم بكلمة أجنبية تلوكها .. بتصفيفة للشعر .. بثوب كان لسيدتها .. وباحتقار لكل ما يمثلونه، في محاولة لا شعورية لتعويض النقص الذي أحست به أمام سادتها.
وكان هناك الذين رضعوا لبن الوطن الأم !! ولم يُفطموا بعد .. منحتهم فرنسا الفرصة – لسبب أو لآخر – لكي يعيشوا حضارتها ويتسلقوا ثقافتها .. هؤلاء تقطعت أنفاسهم فلم يجرؤوا على الصعود أكثر .. على اكتشاف أنفسهم .. على استغلال ما تعلموه للبحث عما يجب أن يتعلموه .. منهم الذين كانوا على شئ من شفافية النفس وعمق البصيرة .. فانصاعوا لأوامر التاريخ وحتميته، ومنهم من تملكه الخوف فانضم روحيا إلى من تربطه بهم أوامر اللسان.
وفي الفوضى التي أحدثها الفراغ الإداري بعد رحيل الأوروبيين أمسكت هذه المجموعات بأجهزة الدولة .. الجهاز الذي يربط القاعدة بالقيادة ..
وجد المسود نفسه فجأة في مقعد السيد متمتعا بجل امتيازاته .. وأصبحت مجرد فكرة مغادره له – حتى لتناول الغداء – مصدر رعب .. وسيطرت على الدولة عقلية ” البيان فاكان ” (الأملاك الشاغرة التي هجرها الفرنسيون الفارّون).
هؤلاء كلهم كانت مصلحتهم الشخصية تتعارض مع رجوع الجزائر إلى الحظيرة العربية بصورة عملية .. لم يكن يرهبهم موقف سياسي متجاوب مع الآمال الكبار للأمة بقدر ما يقض مضجعهم .. أن تصبح اللغة العربية .. اسما ومدلولا .. اللغة الرسمية في الدولة .. وبقدر ما كانوا من أسبق الناس لحمل شعارات التعريب بقدر ما كانوا معاول لتحطيم مضمونه.
معنى هذا إذن أن أمامنا الآن قاعدة شعبية .. مازالت العربية بالنسبة لها تحمل معاني السمو الروحي .. ومجموعات انتهازية ترسم إستراتيجية واسعة المدى لكي يلوث اسم العربية .. ولكي تظهر .. لغة عجز وتأخر .. ولكي يظهر دعاة العربية .. كصوت من العصر الحجري.. يثير الرثاء.
-
التساؤل الذي يفرض نفسه ..
-
أين دعاة العربية .. وكيف كان دورهم وقبل كل هذا .. من هم رجال الصف العربي؟
جل المثقفين بالعربية .. إن لم يكن .. كلهم .. من أسر بسيطة متواضعة .. هم بحق الوجه الحقيقي للطبقات الكادحة (…) ومعنى هذا أن الأب لو خُيّر لما اختار الدراسة العربية، ولنفس السبب البسيط .. من أن الأب يرجو الخير لابنه .. والمستقبل – هكذا كان يراه – مكفول بدراسة الفرنسية.
ويقول معترض لقد كان الدافع الديني هو الأساس .. لكني أقول .. هذه استثناءات .. والنادر يحفظ ولا يقاس عليه.
وأنتج الفقر والعوز .. الأزهار التي تفتحت من بذور جمعية العلماء .. والثمار التي أنتجتها هذه الأزهار ونضجت في معاهد الشرق العربي .. وكان هذا هو الجيش الذي وضعت الأقدار على كاهله عبء إعطاء التعريب مفهومه المتكامل.
ولقد كان عمل المثقف العربي قبل الاستقلال واحتكاكه بالإدارة محدودا .. مما أفقده كثيرا من لزوميات الخبرة الإدارية على مستوى الدولة .. وهكذا وبرغم الرصيد الذي أضيف إلى الصف العربي من خريجي المعاهد العربية العليا بعد الإستقلال .. فإنه ظل من الناحية النوعية عديم الأهمية كعنصر موجه، وكأداة فعالة لتحقيق التعريب، ذلك لأنه – وفقا للإستراتيجية الموضوعة – دفع دفعا إلى الدخول في معارك جانبية لإثبات الوجود الفردي .. امتصاصا لجهده وفعاليته .. ومنعا له من التحرك كمجموع متناسق.
الإستراتيجية كانت تقتضي أن يشل المثقفون بالعربية .. كمجموع، وإن يبدو، كأفراد، عاجزين عن العمل بينما، يبدو الناطقون بالغو ” !! بمظهر العارف الفاهم المدرك .. رجال المواقف والشدائد.
وكانت تقتضي بأن تظهر الفرنسية كأنها قدر لابد منه، بينما تدمغ العربية بكل نقيصة ممكنة .. من التأخر والتخلف إلى .. الاستعمار .. أي والله .. الاستعمار !!
هنا .. والتزاما أمام الضمير .. أقف لأقرر حقيقة بسيطة .. كانت أساسا للكثير .. يقولون هنا – تبريرا – هي السبب، ويقولون هناك – تحذيرا – لقد ضخمت وبولغ في تقدير أثرها .. ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف بها كواقع حي عشناه.
الحقيقة .. هي أن واردات المشرق العربي – وهو رمز العروبة في بلدنا – لم تكن كلها فوق مستوى الشبهات .. كانت هناك الأخطاء على المستوى السياسي والفردي .. وكانت الحماقات والهنات والتفاهات .. حقائق لا تنكر .. الخلاف الوحيد هو على الكم .. لا على النوع (..)
وصدم شعبنا بما رأى .. بما عُرض عليه تحت العدسات المكبرة .. وكانت ردود الفعل كارثة على الإيمان بالتعريب.
وهكذا أصبح عندنا ضيق الأفق الذي لم يحاول البحث عن جوانب الخير، والذي كان من كسل الضمير بحيث لم يكلف نفسه عناء التفكير.. كالقروي الساذج .. يصدق فعلا أن الساحر يخرج الأرانب والطيور من قبعته .. وانضم إليه صديقنا القديم الذي يؤمن دائما بأن العربية لغة الجنة .. فقط، ومعهم الشاب العصري .. صديق الخنافس ومُريد بريجيت (ولم يظهر في الأمة العربية من يمكنه ملء فراغ الخنافس وبريجيت)، هذا بدون أن ننسى فتاتنا المتقدمة .. ولها العذر .. فكريستيان ديور ليس عربيا .. وهي لا تستغنى عن كريستيان ديور.
وازداد رصيد القوة المضادة للتعريب .. في بلد تنهال عليه مئات الأطنان من الصحف والمجلات والكتب الفرنسية وفي بلد تبلغ نسبة الأفلام الناطقة بالفرنسية فيه حتى (الأمريكية منها والإنجليزية) أكثر من تسعين في المائة، وفي بلد يضيع فيه الخطاب المعنون بالعربية وتهمل الشكوى أو الطلب المكتوب بغير الفرنسية، في بلد تنظم فيه حملات محو الأمية للفلاحين والعمال .. بالفرنسية (وافهم يا لفاهم) .. وفي بلد كهذا .. يصبح الحديث عن التعريب – بعد ثلاث سنوات من الاستقلال – وعبر بحر من الدماء والآلام .. يصبح الحديث أضحوكة باكية .. وسخرية مرة.
السؤال يعود ملحا .. كألم الأضراس ..
-
المثقفون بالعربية .. حماة هذه اللغة ودعاتها ودعائهما .. أين كانوا ؟ كيف عجزوا عن صد هذا التيارات ؟ ولماذا – وهم الصورة الحقيقية للشعب المناضل الصامد – لم يستطيعوا فتح أعين شعبهم .. على الخدعة التي جازت عليه .. قرنا وربع .. وثلاث سنوات ..
لقد كانوا هناك .. ولكن …. “عمي مليح .. وزادو الهوا والريح” !!
وقصة الثيران الثلاثة وأسد الغابة تكررت .. أكاد أقول .. بكل تفاصيلها.
بقدرة قادر .. خُلقت هوة سحيقة بين الأساتذة الذين حملوا مشعل العروبة في ليل الطغيان الحالك وبين أبنائهم الذين أتموا دراساتهم في جامعات الوطن العربي .. وفات أولئك أن نجاح الابن عنوان لقوة أبيه .. كما فات هؤلاء أن الغصن جزء من الشجرة.
وإذا كان الذين استكملوا دراساتهم تبعا للنظام العلمي المنهجي في الجامعات والمعاهد العليا أقدر الناس على رسم البرامج الدقيقة للتعريب – مثلهم في ذلك مثل الجندي الذي تشرب التاكتيك العسكري بالصورة الأكاديمية المنهجية – فإن هذه المقدرة كان يجب أن تلتقي مع خبرة آبائهم الروحيين التي استمدت من واقع التجارب اليومية عبر العشرات من السنين .. كانوا فيها مكافحي الجبال الصامدين.
ولكن الجهود تشتتت .. ونظر المكافح القديم إلى ابنه بشك .. وتوجس .. بل وساهم – مدركا .. أم متجاهلا .. – في محاولة تحطيمه .. ونظر الابن إلى أبيه في ألم .. ثم في كره .. وأنقسم الصف العربي .. وتُرك الأبناء وحدهم في الميدان. والباقي .. كله معروف .. فعدم الاعتراف بشهاداتهم العلمية الجامعية وعزلهم في ساقية التعليم .. معصوبي العينين بثقل العمل اليومي وضغط المطالب العائلية والعاهات الناتجة عن السير الطويل في الطريق الشائك المظلم .. حولت حزمة العصيّ الصلبة إلى عصى متناثرة يسهل كسرها وتحطيمها.
وتنفيذا لسياسة العزل دمغ الشباب الواعي بالانحراف المذهبي (البعثي) بعد دراستهم في الشرق العربي ( في بلدان ما زالت الخطوط الرئيسية لإيديولوجيتها في طور الإعداد للاستهلاك الداخلي! !) .. وفات الجميع أن تهمة كهذه – إن صح توجيهها لمواطن – يجب أن توجه إلى الذين درسوا حيث تكون المذاهب السياسية جزءا رئيسيا من الدراسة والعمل اليومي (والأمثلة معروفة).
-
المؤلم هنا أن الآباء ساهموا في محاولة العزل.
-
والمثير هنا أن المثقف العربي – بما هو عليه من ضعف ناتج عن الفردية – أصبح يتحرج من الدفاع عن وجهة نظره حتى لا يتهم بالتبعية ويحارب في رزقه .. في أمنه وسلامته.